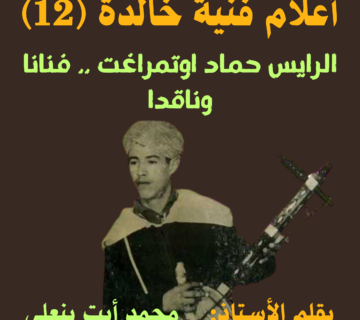أسايس وأزمة الإنشاد الشعري
وجهة نظر ممارس
بسم الله الرحمن الرحيم
مقدمة:
حينما يقول لنا المثل الشعبي السوسي “كون أزمز د سّكت نّس”، لا يسعنا إلا أن نسير على منواله، فكل زمن له منتوجه الثقافي والأدبي، ولكننا ملزمون دائما أن ندافع عن قيم الزمن الذي نعيش فيه، وأن ننتقد ما جدّ من الأمور التي لا تساير ثوابت الإبداع في هذا الزمن، و سوف نلاحظ أنّ أبرز متغيرات وقتنا الراهن هو ما يتعلّق بالتواصل والاتصال، فقد أدركنا زمانا فيما قبل التسعينات لا تصلنا أخبار ميادين الإنشاد الشعري إلا بعد أن تلوكها الألسن عن طريق الرواية أو التسجيلات الصوتية والبصرية، وقبل ذاك كانت الأخبار تصل فقط عن طريق الرواية، أمّا اليوم فإنّ الخبر يصل إلينا بطريقة محمومة وبدون إنذار أو إشعار، وقد استفاد الشعر الشفوي من هذه المتغيرات كثيرا، فحينما تفتح صفحة من صفحات التواصل الاجتماعي عبر الأنتيرنيت تصادف كلّ شيء عن ميدان الإنشاد في حواريات أحواش، أيا كانت البلدة التي حدث فيها الحوار بين الشعراء، وهذا المعطى التيكنولوجي لا يترك صغيرة ولا كبيرة إلا وقد بثها في آذان المهتمين بالظاهرة الشعرية، ولكن الإشكالية التي تقضّ مضجعنا كمهتمين يحملون غيرة على الشعر الإمازيغي، لا تكمن فيما يوفره هذا التواصل السريع، بل في الطريقة التي يتمّ بها التفاعل مع المستجدّات من طرف جمهور عريض مختلف في رؤاه وتصوراته حول الشعر، فقبل منتصف التسعينات كان المكان الوحيد الذي يتمّ عبره التواصل بين الشاعر والناقد هو “أسايس”، وكان هذا الفضاء لا يستقطب إلا ذوي الذوق الأدبي الرفيع، وقد يلجأون إلى التدخل الآني من أجل تصحيح الانحرافات عن الضوابط الفنية للشعر الشفوي، فيما يمكن تسميته بالنقد المباشر، وبعد انتشار هذا الشعر عن طريق الرواية أو التسجيل يحظى بالمزيد من النقد، ممّا جعل الشعراء يكونون حذرين من الوقوع في المنزلقات، ويحاولون صياغة شعرهم بكيفية رزينة مستفيدين ممّا حفظوه من شعر من سبقهم، أمّا الآن فإنّ قواعد اللعبة قد تغيّرت، فقد غاب نقاد الكلمة الشعرية عن ميادين الإنشاد وحلّ محلهم جمهور لا يعرف عن الشعر شيئا، ولا يهمه سموّ المعاني ولا الميزان ولا التراكيب اللغوية الرصينة، ممّا نتج عنه ظهور شعراء انتهازيين دخلوا إلى أسايس بقرونهم وبجرأتهم الخالية من الإبداع، وفي هذه الورقة سوف أحاول المقارنة بين عهدين فيما يخصّ الإنشاد الشعري، عهد يحترم فيه الشاعر أدبيات الإنشاد، وعهد هبط فيه مستوى الإنشاد إلى الحضيض، متسائلا: كيف وهل يمكن للنقد أن يرجع لهذا الإنشاد يناعته أم أننا سوف نردد “كون أزمز د سّكّت نس” فنغمض أعيننا ونغلق آذاننا ….
الفصل الأول
الإنشاد في أسايس في الزمن الجميل
توطئة:
لقد أدركنا عقودا زمنية رائعة كان فيها الحوار من الثوابت الأساسية في إبداعات أحواش، وكان الشاعر حينما يدخل إلى ميدان الحوار لايفضي بأي مطلب سوى أن يجد شاعرا في مستواه يحاوره وأن يجد الظروف الملائمة للحوار، ومن بين المأثورات التي تشير إلى هذا الهاجس طلب واستدراج شاعر لشاعر آخر حينما يخرج إلى أسايس كما قال شاعر أفرا سيدي بوسلام ؤعمر وهو يطلب لقاء الشاعر مبارك ؤمسعود بن زيدا:
أنيني نعام ئ مادّ ئسكرن تيليفوتن
أربي فكاتيد مبارك أسرسن ساولخ
وقد تركت مثل هذه الهواجس سيلا عرما من الأبيات الشعرية كلها تدل على أن الشاعر يتوق دائما إلى من يحاوره ويمتعظ إذا لم يسعفه هذا المطلب، منها مثلا :
ؤكون ئس نوفا مادّ نتمون ف واوال نخ
أها أسكا أد نغُيت ئس ئلا ويس سين
وفي جميع فنون أسايس نجد إيماءات وعلامات على أن الحوار من مستلزمات الإنشاد، بل إن الشعراء غالبا ما يلحون على الحوار وعلى أن يكون هذا الحوار متكافئا، فالشاعر بووزنير يمتعظ لأنه لم يجد أمامه شاعرا كفءا يحاوره فعبر عن امتعاظه:
ربّي صامحي ضوراد أشكو ننغا قمشيش
أربامت أيست تمازيرت ئميكّ ن وامان
أسرسن سليغ ئضوضان ماتّ أكُ ئرا يان
والحوار هو الذي يذكي النقاش في مختلف القضايا وغيابه معناه شح المعلومات وشح الإبداع بل هو الذي يستقطب العدد الأكبر من الجماهير من بين التعابير الفنية الأخرى، ولعل أول سؤال يطرحه الجمهور حينما تصل إليه أخبار عرض من عروض أحواش هو: من هم الشعراء المدعوون لذلك العرض؟، على هذا الأساس سوف أتحدّث عن الإنشاد في الزمن الجميل، زمن كان فيه أحواش وسيلة لتخليق المجتمع، عن الكفايات التي لا بد من الشاعر أن تتحقق لديه، وعن بعض الأدبيات التي يتعيّن على الشاعر أن يحترمها ..
1- كفاية الإنشاد الشعري في فنون أحواش:
الكفاية “تاسوكَرت” لدى شاعر أسايس تدلّ على استنفار الكثير من القدرات الفائقة تمكنه من مواجهة وضعية حوارية ميدانيّة معيّنة يبلّغ من خلالها رسالته، فارتياد هذا الفضاء قد لا تسعف فيه التلقائية المفرطة والحظ والتهوّر على أية حال، بل يتعيّن على الشاعر أن يجد لنفسه متنفّسا من خلال هذه المقولات وإلا وجد نفسه على الهامش أو في الدرجات الدنيا، إن أهمّ ما استشففته كممارس في ميادين الحوار الشعري أنه لا يسوغ للمشارك في الحوار أن يتقدم إلى الميدان إلا بعد أن تتوفر لديه الكفاية اللازمة للصناعة الشعرية والإنشاد، فهناك البعض من المغمورين الذين تدفعهم الجرأة لكي يواجهوا شاعرا بدون أن يتأكدوا من قدرتهم على الارتجال في الإبداع، وهؤلاء قد لا يعرفون بأنهم يساهمون في تجريد أسايس من مصداقيته كمجال للإبداع، فقد جاء الشاعر الكبير “لحسن بووزنير” ذات يوم إلى أحد المداشر للمشاركة في حوار شعري بمناسبة عرس فتقدم أحد المغمورين ليحاوره، ولما ألفى أن هذا المحاور ليس كفءا قال معبرا عن استيائه:
ربّ صامحي ضّور أد أشكو ننغا قمشيش
أربامت أيست تمازيرت ئميك ن وامان
أ سرسن سليخ ئضوضان ماتّ أكُ ئرا يان
وعلى أساس مثل هذه الوضعيات يمكن لنا أن نلاحظ الشاعر الكفء المتمتّع بالجدارة واقفا بفضاء أسايس وفي مختلف الأوضاع، لكنّني لا أعني بالوقوف ذلك الوقوف العفوي العارض الذي يتأتى لشاعر مّا في لحظة محددة، بل أعني به الوقوف المستمرّ الذي يضرب له الشعراء الأنداد أيما حساب وهم يقبلون على مواجهته في لحظات الارتجال الشعري، وغياب هذا الوقوف قد يحرج الشاعر المبدع، السؤال إذن هو كيف أمكننا مقاربة هذه القدرات بالمواجهة الشعرية الارتجالية بأسايس؟ هناك سلسلة من القدرات التي تتحقق معها كفاية الإنشاد:
أ- القدرات المعرفية للشاعر:
تتأسس هذه القدرات المعرفية على مناح عدّة كلها تتعلق بما قبل ارتياد فضاء الحوار الشعري، ويتم اكتسابها عن طريق استظهار الشاعر لإبداعات من سبقوه من أجل اكتساب الكفاية اللغوية المتعدّدة الأبعاد، ومدى تجواله في مختلف الأصقاع والقبائل ، وتتركز هذه القدرات على:
أ-أ: المعرفة بالقواعد المورفولوجية والتركيبية والإملائية لللغة الأمازيغية: وتميزاتها في المناطق التي تعتبر ميدانا لممارسة الحوار الشعري لدى الشاعر، فالمعرفة الجيّدة لقواعد الاشتقاق والتصريف وأدوات المعاني وقواعد الإملاء ومختلف التراكيب وغيرها وكيفيات توظيفها تجعل الصناعة الشعرية الارتجالية في متناول الشاعر ..
أ-ب: المعرفة بمعجم اللغة الأمازيغية المستعمل في جميع المناطق التي يرتادها: إن ما نراه اليوم لدى عدد من الشعراء الذي يلجأون وبكيفية مريعة إلى الاقتراض المعجمي وبكيفية محمومة وذلك باعتمادهم على اللغات الوافدة وخصوصا العربية، لا ينمّ إلا على شيء واحد وهو أن هؤلاء الشعراء يطعنون اللغة الشعرية طعنات مميتة ومقيتة، ولعلّ هذا بمثابة عقدة سيكولوجية ناجمة عن الشعور بالدّونية بتبخيس لغتهم وتبجيل لغة الوافدين، وهذا الانزياح هو الذي اتخذه العديد من النقاد المحدثين كأساس لتقزيم شعر أسايس والقول بأنه دون شعر القصيدة الحديثة “تامديازت تاماينوت”، والحقيقة أن هذا الانسياق كان غير مألوف في فضاءات أسايس، إلا ما تفرضه الضرورة الشعرية بطبيعة الحال، إذ أن الاقتراض المعجمي لا يمكن اللجوء إليه إلا في حالة انعدام اللفظة المناسبة في لغتنا اوفي حالة عدم انصياع اللفظة لميزان الشعر، ولكننا في هذه الحالة يجب أن لا نكون إمعة نستورد كل ما لدى غيرنا دون أن نأبه بثراء معجمنا اللغوي الأمازيغي، ومع ذلك فإنّ الشاعر لابد له أن يلجأ إلى الاقتراض المعجمي حفاظا على جمالية المقطع الشعري شريطة أن يتمّ تنميط اللفظة المقترضة بإلباسها رداء أمازيغيا….
وقد لوحظ في فضاءات أسايس أنّ الشعراء يتأثرون في لغتهم بالظروف الجغرافية السائدة في بلداتهم، ومن السهولة أن تميّز شعراء الجبل الذين يعيشون بين الصخور والأعراف الجبلية كالأطلسين الصغير والكبير وشعراء المناطق الواطئة الذين يذرعون الوهاد السهلة كالمناطق الصحراوية وسهل سوس، فالفئة الأولى تلجأ إلى النحت اللغوي والإدغام القسري وتوظيف اللفظ ذي الصبغة التنافرية أما الفئة الثانية قتحترم الأصول الاشتقاقية للكلمة وتلجأ إلى الألفاظ السلسة، ولا شك أنّ اختلاف الأصوات الأبجدية بين بعض المناطق له تأثير آخر ف هذه الإبداعات، فالنطق بالحاء بدل الخاء والغين أو العكس قد يؤثران في بنية الكلمة والوزن الشعري، خصوصا حينما نعرف بأن كل بيت شعري توفر على مقطع يحمل حرفا ثقيلا وأن من بين هذه الحروف الثقيلة حرف الغين الذي لا يجوز بأي حال أن يتحول إلى حاء أو خاء…
أ-جـ: المعرفة بعادات وتقاليد ومواصفات جميع تلك المناطق: ولن تتأتى له هذه المعارف إلا بالحضور الفعلي والمكثف في فضاءات الشعر، والتجوال في مناطق يسود فيها الحوار الشعري، وفي مختلف القبائل كفيل بأن يُلِمّ بلهجاتها إلماما جيدا عن طريق المقارنة والتمحيص، إن أبرز الزّلات التي يمكن أن يقع فيها الشاعر تتعلق بألفاظ أو عبارات محرجة أو مثيرة للسخرية والضحك، أو حروف أو ألفاظ أو عبارات غير موظفة بالشكل الصحيح، فالشاعر عليه أن يكون حاملا للفكر والمعرفة أي أن يكون عالما متضلعا في أحوال القبائل والجماعات بل وحتى النخب السياسية والثقافية، فقد يدعى إلى حوار شعري أمام جمهور قبيلة معينة فينطق بما يشير إلى حدث أو أي شيء يثير العواطف أو يحيي جراحا مندملة، ولهذه الظاهرة أمثلة كثيرة لدى شعراء سوس، ولذا نجد بعض الشعراء حينما يقبلون على زيارة فضاء جديد عنهم يبادرون إلى جمع المعلومات عن ذلك الفضاء حتى لا يؤاخذوا على حين غرة.
ب: القدرات المهارية:
إذ لا يسوغ للمشارك في الحوار أن يتقدم إلى الميدان إلا بعد أن تتوفر لديه المهارات والمواهب اللازمة للصناعة الشعرية، فهناك البعض من المغمورين الذين تدفعهم الجرأة لكي يواجهوا شاعرا بدون أن يتأكدوا من قدراتهم على الارتجال المفعم بالإبداع، ومن أهم المهارات المرتبطة بالإبداع الشعري الشفوي:
ب-أ- المهارة الصوتية: فالحنجرة لدى شاعر أسايس بمثابة الأداة الضرورية لإيصال رسالته إلى الجمهور، وتتعلق هذه المهارة بمستويين متلازمين، المستوى الأول هو مستوى تمرّن الأهداب الصوتية على أداء جميع النغمات المتوفّرة في ميادين الإنشاد الحواري، والمستوى الثاني هو مستوى القدرة الفائقة على التمييز بين النغمات الخاصّة بكل فن من فنون أحواش أو الخاصة بوصلاته المتميزة، ويشمل هذا التمييز كذلك تمرين الحنجرة على أصناف النبرات التي يتميز بها كل مجال جغرافي، وتتعدّى هذه المهارة حدود النغمات المألوفة في النطاق الجغرافي لفن من فنون أسايس إلى النغمات السائدة في نطاقات جغرافية أخرى لدى الشعراء العباقرة، ومن أهمّ الشعراء المعروفين بأدائهم الصوتي الذي يمتزج فيه الشجا بقوّة الصوت وجهوريته الشعراء الرعاة أي الذي مارسوا الرعي، فهم يلجأون أثناء تواجدهم بجوار القطيع في المرعى إلى تمرين أهدابهم الصوتية، ومن أهم ما لوحظ أثناء المقارنة بين فنون أحواش وأحيدوس أن فنون أحواش تنتابها غزارة من الأصوات والنغمات حيث نجد أن بعض هذه الفنون تستقطب عددا هائلا من النغمات لا يتمكن منها إلا الشاعر العبقري، بل يعتبر الصوت والنغمة تحديا كبيرا إذ بواسطته يستطيع الشاعر قهر شاعر آخر ولو فاقه من حيث القدرات المعرفية والمهارية الأخرى …
ب-ب: مهارة البناء العروضي “تالالايت”: التي تشير إليها العبارة المألوفة في وسط الأطلس الصغير “تاوّاسنا ن ئغُزَا ن لّغا“، والسبيل الوحيد للتدرّب على اكتساب هذه المهارة هو حفظ النصوص الشعرية الكثيرة ومن مختلف الأوزان، ولكن الشاعر مطالب بأن يذرع ميادين الحوار وأن يستمع إلى مختلف النماذج لكي يعرف كيف يمكن له أن يمايز بين هذا الوزن أو ذاك ولكي يتعرّف على الأنماط المتشابهة من هذه الأوزان، هذا فضلا عن اكتشافه لارتباط بعض هذه الأنماط بفنون محددة، إن أوزان الشعر غزيرة في فنون أحواش وهي تتجدد بكيفية مستمرة وخصوصا عن طريق التجزيء والتركيب، ومن أهمّ ما يعبر فيه الشاعر عن براعته في تشخيص الميزان قدرته على توظيف العمود الثقيل «أسقول» الذي يعتبر عندنا بمثابة القافية في الشعر العربي، فكل وزن كما سبق أن رأينا لا بد أن يتوفر على مقطع يحمل حرفا ثقيلا..
ب-جـ- مهارة الاستماع وسرعة الرّد: وتتأسس على الصياغة الشعرية السريعة، فهو أمام مشهد يتم فيه ارتجال النظم بسرعة غالبا ما تكون محمومة خصوصا في نموذج “أحواش سهل سوس”، وهذه الصفة تتطلب منه أن يستمع بحذق إلى كل ما يستعمله محاوره من ألفاظ ومعان ودلالات وأفكار، وأن يفتح عيونه لكي يرصد كل حركة أوسكون في فضاء الحوار بأسايس، وأن يجد اللفظة المناسبة للمكان المناسب في الوزن الذي يتمّ به الحوار، ففي هذا الفضاء لا مجال للسهو أوالغفلة وإلا كان ذلك مؤديا إلى ضياع الفرصة والانحراف عن القافلة…
ب-د: مهارة الإبداع البلاغي والتصوير: أو ما يصطلح على تسميته ب « لمعنا»، وهي التي يمتطي بها الشاعر قمّة الإبداع، فالشاعر ملزم بأن يعرف كيفية استثمار أساليب المعاني والبديع كالتشبيه والاستعارة والمجاز والطباق والجناس، وهذه المهارة هي الوسيلة المثلى للصورة الشعرية والترميز، ونحن نعرف بأنّ الشعر الذي يفهمه الجميع قد لا يجعل الشاعر في مصافّ كبار الشعراء كما سنرى أثناء تطرقنا لنقد التعابير الفنّية….
2- أدبيات الحوار الشعري في فنون أحواش:
من يشاهد فنون أحواش عن كتب سوف يعتقد لأول وهلة أن الإنشاد الشعري تغلب عليه العفوية والتلقائية وأنّ الشعراء يمارسون النظم بحرية تامة في غياب أي نظام، ولكن بشيء من التدقيق سوف نكتشف أن الإنشاد الشعري في هذه الفنون ينضبط وفق أعراف وتقاليد لابد من احترامها، هذه الأعراف التي لا تؤثر سلبا على ملكة الإبداع بقدر ما تزيدها ثراء ورونقا، وهكذا وجدنا أسايس وهكذا تعاملنا معه رغم ما عرفه من تغيرات، وتتجلى هذه التقاليد في القدرات التواصلية والاندماجية التي تتجلى من خلالها أدبيات الحوار، وهي القدرات التي يتمكّن بها الشاعر من أن يجد لنفسه مكانة مرموقة في ميادين الحوار، وتتعلق بمواصفات عديدة تشكّل خصالا مألوفة ترفع من شأنه كمحاور ويتعين عليه مراعاتها أثناء تواجده في مواجهة بينه وبين الشعراء، ومن خلالها يجب عليه أن يكون سيّد نفسه، فهناك من الشعراء الذين اقتحموا فضاءات أسايس اليوم من يعتقدون أن الشاعر حر في الإدلاء بكل ما لديه وفي أي موقف أو لحظة من الشعر بدون أية رقابة ووفق ما يتمتع به من حرية في الكلام، بيد أن حواريات أسايس لها أدبيات أو أخلاقيات لا بد من الشاعر أن يتقيد بها وإلا فقد مصداقيته لدى محاوريه ولدى الجمهور، وقد لوحظ كذلك أن بعض المجاملات والاعتبارات الحميمية قد تجعل حراس هذا الميدان الشعري يتغاضون عن الأخطاء التي يرتكبها شاعر حينما لا يتقيد بتلك الأدبيات، كما يحدث للشعراء الكبار الذين لا يعرفون ضوابط الحوار والرد في قبيلة يزورونها لأول مرة، وعلى العموم فإن الحوار الشعري بأسايس يتطلب مراعاة جملة من الأدبيات تساهم في الرفع من قيمة الحوار وفي الإبداع المتسم بالروعة والجمال ومن أهم هذه الأدبيات :
2-1: الحجز المنطقي للمقعد في الحوار:
فلا يسوغ للشاعر أن يدخل في حوار جار بين شاعرين آخرين إلا إذا دعي وطلب منه ذلك، وهذه الأخلاقية الشعرية غالبا ما تلاحظ في جميع فنون أحواش، ففي أكَوال بمنطقة «ئبركاك» نجد أن الفتيات أثناء إنشادهن لا يستسغن أن يجاب على شعرهن إلا من طرف من يطلبن محاورته صراحة، وإلا اعتبر تدخل الشاعر الغير المطلوب للحوار تطفلا وتعرض للتقريع منهن، وفي جميع الحواريات لا يستسيغ الشعراء المرموقون الحوار بين أكثر من شاعرين أو ثلاثة يعطون للموضوع ما يستحقه من التركيز والإثراء حتى لا يتدخل رابع وخامس لإفساد الحوار، لكن بعض منظمي سهرات أحواش من أمازيغي سوس يرتكبون خطءا فادحا حينما يدعون عديدا من الشعراء لكي يساهموا في حوار واحد، وقد لوحظ أن هؤلاء لا يفعلون ذلك تكريما للشعراء وإنما للتباهي فقط، ولطالما شبّه أحد الشعراء هذه الثنائية في الحوار بعملية الحرث “يان أيلوح أمود نس ئشوور فلاس+ ويسّ سين ئنمالا د ؤضرف ياسي تاوالّوت”، وما هو ملاحظ أن الشاعر الذي بدأ في فرض وجوده بأسايس قد لا يتدخل بحضور أساتذته الذين تربي في أحضانهم حتى يفسحوا له الطريق بإشارة أو بكلام صريح، وقد رأيت هذا المشهد في منطقة أقا وبأكادير ؤوزرو ذات مرّة حيث تقدم شاعر كبير ومسّ يد شاعر مبتدئ إيذانا له بممارسة الحوار.
على أنّه لابدّ من الإشارة إلى أنّ هذا الحجز للنوبة في الحوار قد تختلف من عرض إلى عرض، ففي المناسبات الاجتماعية كالأعراس يعتبر كلّ شاعر مدعوّ من طرف أهل العرس حاجزا لنوبته، وفي المهرجانات التي تنظمها الجمعيات يمكن قول نفس الشيء، أمّا في المواسم التي يأتي إليها الشعراء من كل حدب وصوب فإنّ كل شاعر زائر للموسم له الحقّ في نوبته في الحوار، وقد يلجأ منظمو الموسم إلى مخالفة هذا التقليد تثمينا لبعض الشعراء على حساب شعراء آخرين، ولكنّ هذا السلوك غير سليم بتاتا.
وفي جميع الأحوال فإنّ احترام النوبة في الشعر الحواري من أهمّ التقاليد المتعارف عليها، وفي هذا الصدد يمكن الحديث عن وضعيتين:
+ فإما أن يبادر أحدهم منذ البداية إلى طلب محاور له وآنذاك يتعين على الآخرين الذين يحضرون الحوار تركهما لكي يستكملا حوارهما حتى يطلب منهما الدخول في الحوار، والواقع أن الشاعر الحاضر الذي لايشارك في الحوار يجد نفسه كمن جلس على الجمر لأنه يحدوه حماس كبير لكي يشارك خصوصا إذا ساورته فكرة يكمل بها ذلك الحوار..
+ وإما أن لا تكون هذه المبادرة مطروحة منذ البداية، وفي هذه الحالة يتعين على الشعراء احترام النوبة أي إعطاء كل شاعر حقه في الإدلاء برأيه إلا إذا تنازل عن هذا الحق طواعية، والواقع أنّ لجوء الشاعر إلى تهميش زملاء له في الحوار ليس من أدبيات أسايس، وقد خلقت هذه الوضعية التي تكررت كثيرا في ميادين الحوار الشعري بسوس كراهية وتنافرا ملحوظا بين فئات من الشعراء أدت إلى أحداث مؤسفة وهجاء تجاوز الحدود المألوفة، وقد طرح هذا المشكل غير ما مرة في منتديات الحوار حول إشكاليات أسايس..
2-2: استيفاء موضوع الحوار كل متطلباته:
إذ لا يسوغ للشاعر أن يسارع إلى وصلة “أسٌوسٌ” إلا بعد الانتهاء من معالجة الموضوع والإحاطة بكل جوانبه، بحيث أن هذه الوصلة تعتبر دائما بمثابة الخاتمة أو كما تسمى لدى الشعراء “تاسلكَرت” أو “تاسقٌونت”، ولا يمكن اختتام الشيء قبل موعده، وإذا قام الشاعر بذلك فهو يعتبر انتقاصا من مقدرته ودليلا على قصر نفَسه في الإبداع، وقد لوحظ مؤخرا أنّ بعض الشعراء المتملّقين يسارعون إلى وصلة أسوسّ من أجل المبالغة في مدح المضيف أملا في الحصول على الأوراق النقدية، ممّا يؤدّي إلى ضياع الكلمة الشعرية الرصينة.
وفي بعض الحواريات حينما تتم الإحاطة بكل جوانب الموضوع، يلجأ المتحاوران إلى تغيير مضمون هذا الموضوع، بل نجد الشعراء في طاطا غالبا ينشدون بيتا مشهورا وهو:
لباب أنّ ريغ أتّ ركَلخ أنارم وايّاض
وذلك حينما يرون أن الموضوع الذي تتم مناقشته قد استوفى وقته، ولا يحتاج إلى ختمه بوصلة “أسّوسّ”، يعني أن الوقت الطويل يجب أن يخصص للحوار والنقاش…
2-3: الانضباط للنغمات والأوزان:
فبالإضافة إلى ما أشرت إليه في الكفايات، لا يسوغ للشاعر أن يلجأ إلى تغيير النغمة أو الوزن الذين ينشد بهما نده في بداية الحوار، مع العلم أن بعض الفنون لها أوزانها ونغماتها ولا يجوز الخروج عن هذه الأوزان أو النغمات، ومن الملاحظ أن بعض المغمورين يفسدون الشعر بالمبالغة في تغيير النغمات لأنهم عاجزون عن الاستمرار، مما يؤدي إلى هبوط قيمة الحوار الشعري، لكن تغيير النغمة من جراء طول الحوار قد يلجأ إليه الشعراء لإزاحة الملل عن المتفرج والمردد، كما نجد كذلك تغيير النبرة الحادة إلى نبرة أخف منها، لذا فإن الشيء الغير المستساغ هو التغيير الغير المبرر أو المعبر عن العجز، ونلاحظ أن بعض المغمورين من الشعراء أو المرددين غير المتمرسين لا يتورعون عن المطالبة بتغيير النغمة ” سنفلات أغ لغا” وهذا انتقاص من قدر الشاعر على كل حال، لذا فإن النغمة أو الوزن غالبا ما يشكلان تحديا في عالم الحوار الشعري بأسايس، وكثير من الشعراء الموهوبين انطفأت شعلتهم بسبب قصورهم عن مجاراة النغمات الحادة أو الأوزان المعقدة، وهذا يرتبط غالبا بمهارة الإنشاد الشعري ..
2-4: تحاشي التكرار والاجترار في الشعر:
إذ لا يسوغ للشاعر أن يعيد ما قاله في حوار آخر إلا إذا كان هنالك مسوغ إبداعي، والواقع أن الشعراء مختلفون في هذا الأمر، فهناك من يحبذ إعادة الشاعر لشعره إذا كان المقام يسمح بذلك، ولكن أغلبية الشعراء يمقتون ذلك، لأنه دلالة على العجز ونضوب الموهبة الإبداعية.
2-5: العفاف في التعبير:
فالشاعر يتعين عليه أن يكون حريصا على احترام مشاعر المجتمع الذي يحضر في ميدان الحوار، وهو مجتمع يتميز بكونه يتألف من مختلف الأعمار ومن الذكور والإناث فضلا عن كون الأسرة الواحدة ممثلة فيه بجميع أعضائها الكبار والصغار، لذا فإن الشعراء يجب أن يحترسوا من ذكر ما قد يسيء إلى الأخلاق والآداب العامة المألوفة في المنطقة، وخصوصا أثناء الوقوع في الهجاء أو أثناء التطرق للفضائح الأخلاقية، ويعتبر استعمال الترميز والتلميح من بين مخرجات الحديث عن هذه الوضعيات المعقدة، وقد لوحظ أن هذا العفاف مطروح حتى في الغزليات إذ يلجأ الشعراء إلى الرمز ويستنكفون ذكر المرأة وذكر مفاتنها على عكس ما نجده لدى بعض الإثنيات كما عند العرب..
6-2: احترام التميزات في مختلف فنون أحواش:
فمنطقة سوس تزخر بالأنماط الفنية التي تختلف أدبياتها الحوارية، والشاعر مطالب أثناء تنقلاته بأن يراعي تلك الأدبيات المتمايزة، فحواريات أحواش سوس مثلا تستلزم نزول شاعرين فقط إلى الحوار، وحواريات أكوال ئبركاك تستلزم تناوب وصلتي أمخلف وأسوسّ، وحواريات درست تاوزالت وأهناقار ينضبط فيها الشاعر لوصلة أزوكَز إذ لا يسوغ البدء في الحوار في أهناقار إلا بعد المرور عبر تلك الوصلة، أما في درست تاوزالت فرئيس الجوقة يلجأ إلى الوصلة من أجل طرد الملل وآنذاك يتعين على الشاعر إفساح المجال لها، وفي حواريات بووسكَا بالأطلس الكبير فالشاعر ملزم باحترام محاوره الذي ينطق ب “تشوورت” حتى يستكمل مقطعه الشعري، وفي فنّ تازرارت وجدنا تقليدا في الأعراس يتعلق بحواريات هذا الفنّ حيث يلجأ المدعوون إلى العرس من الرجال إلى مناوبة الإنشاد من اليمين إلى اليسار، لذا فإنّك مطالب بأن تنشد حينما تبدأ المناوبة وإلا تعرضت للسخرية، كما أنك ملزم باحترام الوزن والنغمة، وفي حوارٍيات تاماووشت يتعين على الشاعر أن يحترم المراحل التقليدية للحوار وأن لا ينتقل إلى مرحلة إلا بعد استنفاذ سابقتها …
الفصل الثاني
أزمة الانحراف عن الإبداع في فنون أسايس
توطئة: هل يجوز لنا أن نسكت ونستسلم لما طرأ في ميادين الإنشاد؟ أم أننا كمخضرمين من واجبنا أن نذكّر ونومئ إلى الأخطاء والمنزلقات وننصح الشعراء الجدد ونهديهم إلى الطريق الصحيح؟ الحقيقة أن كلّ مجال من مجالات الإبداع الفني في أي مجتمع إنساني يرزح للتطوّر والتحديث، غير أنني أريد أسوق هنا مقولة قالها الدكتور محمد الخطابي أول من أنجز أطروحة حول فنون أحواش، حيث قال ذات مرّة ونحن نتحدث عن هذا التطوّر: “يجب علينا أن نميّز بين التحديث والتغيير في فنون أحواش، فالتحديث معناه إضافة أشياء إلى ذات الفنّ دون الخروج عن ثوابثه، وقد يحاول أبناء عصرٍ الإبداعَ حتى في الخروج بفنّ جديد كما فعل أبناء الحوز والأطلسين الصغير والكبير حينما أسسوا لفنّ تيرّويسا وتيروبّا، وهو مقبول لأنّ الفنّ يتطوّر من عصر إلى عصر، أمّا التغيير فمعناه أن نخرج بالفنّ عن ثوابته وناتي بشيء آخر بدلا منها، وهو غير مقبول”، وعلى هذا الأساس احتفظ أجدادنا في كل قبيلة على جميع أصناف فنون أحواش وأوصلوها إلينا إلى حدود بداية التسعينات، فما الذي تغيّر إذن ؟ وكيف تمّ المساس بالثوابت الأساسية لهذه الفنون؟
نحن نعرف أنّ الظاهرة الملحوظة منذ التسعينات هي تحوّل فنّ أحواش إلى سلعة يتحكم فيها العرض والطلب، فيما يسمّى لدى البعض ب”الاحتراف في فنون أحواش”، وقد طالت هذه الظاهرة شقّين أساسيين من هذه الفنون، وهما: الفرقة الممارسة، والشاعر الممارس للشعر الحواري في أحواش، فأي متغيّرات أثرت على الإبداع من خلال هذين الطرفين؟
1- انحراف الفرق الفنّية:
فيما مضى لوحظ أنّ الأنماط الفنية في أحواش يمارسها الجميع، ولقد أدركت في تاكموت أنّ كلّ قرية لها فرقتها من الرجال والنساء، بمعنى أنّ ممارسة أحواش سلوك عادي منتشر في النسيج الاجتماعي للقرية والقبيلة، ويشارك فيه الناس بمختلف أعمارهم وحرفهم وانتماءاتهم الطبقية، فأحواش يشبه صلاة الجماعة في أنّه ليس حكرا على أحد، ولكن وابتداء من التسعينات من القرن الماضي تغيّر كلّ شيء، فقد انتقلت ممارسة أحواش من سلوك جماعي إلى سلوك نخبوي لعدّة أسباب اختلط فيها الذاتي باللاإرادي، ومن هذه الأسباب :
أ- تغلغل عقدة الشعور بالدونية إلى النسيج الاجتماعي: وهو سبب ذاتي صرف، وبالخصوص أولائك الذين سلبتهم الثقافة الأجنبية وفضّلوها على ثقافة أجدادهم، فالعديد من الناس حينما تسألهم لماذا لا يمارسون أحواش ينطلقون من أنّ ممارسته ممارسة وضيعة لا تليق بالشخص العاقل ومنهم من سخط على جميع الفنون بدعوى أنها مجال للعبث واللهو كالسلفيين الذين هاجموا فنون أحواش بلا هوادة وجعلوا ممارسته طريقا إلى الكفر، ومنهم من سخط على فنون أجداده لأنها بدائية ليست في مستوى فنون الشعوب المتحضرة كما هو الشأن بالنسبة للذين استهوتهم الموسيقى الغربية وأرادوا أن يلبسوا مواصفاتها للموسيقى الأمازيغية، ومنهم من يجعل فنون أحواش مضيعة للوقت بسبب التهائهم بشؤون أخرى كالتجارة والوظيفة العمومية والخدمات الأخرى.
ب- التعصب المذهبي والأيديولوجي: حيث أنّ بعض البلدان كالمغرب منيت بالغزو الثقافي فجعلت فنون البلد الذي احتلّته فنونا من الدرجة الثانية أو الثالثة، وفرضت على أبنائها فنونها في الإعلام والتعليم والعناية الثقافية، ففي بلدنا علّمتنا الدّولة والمجتمع المدني منذ حصولنا على الاستقلال من فرنسا أنّ الفنّ العربي بكلّ مكوناته هو الفنّ الأصيل، وصرفت على تنميته الأموال الطائلة، إلى درجة أنّ بعض الأمازيغ تسلّقوا الرتب في الموسيقى العربية والإبداع الأدبي العربي، وسوف ننتظر إلى سنة 2001 حيث اعترفت الدّولة باللغة والثقافة الأمازيغية وأنشئ المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية الذي أسنتدت إليه مهمة تثمين مكونات الثقافة الأمازيغية ومن بينها الفنون.
جـ – الهجرة والاغتراب الثقافي: فالعيد من أبناء منطقة أحواش هاجروا إلى المدن المغربية وإلى خارج الوطن، ففرضت عليهم الهجرة التواجد في وسط بعيد في ممارساته الثقافية عن الوسط الذي ترعرعوا فيه، واضطرّهم ذلك إلى الانتظام في ثقافة ذلك الوسط هم وأولادهم، وحينما يأتون لزيارة البلدة يحسّون بالاغتراب الثقافي فيجدون صعوبة في التكيّف مع ثقافتهم الأصيلة، بل منهم من يأتي بعينات من ثقافة دار الغربة لكي يؤنس بها وحدته في أحضان بلد أجداده.
د- سلوك السلطات المحلّية تجاه فنون أحواش: فمنذ عهد الاستعمار عوّدتنا السلطات المحلية على سلوك مشين تجاه فنون أحواش، وفحوى هذا السلوك أنّها تسوق ممارسيه إلى المواكب والمناسبات الوطنية قسرا وتحت طائل العقاب، الشيء الذي ولّد ردّا طبيعيا لدى العائلات حيث أنّ جلّ العائلات في بعض القبائل تستنكف أن يتعلم أبناؤها وبناتها أحواش خوف من الانضمام إلى قطيع المناسبات، فأحواش لدى هذه السلطات ممارسة فلكلورية تزيّن الطرقات في المواكب وتعبر عن الولاء في المناسبات الوطنية..
وفي التسعينات بدأ انحسار شديد في ممارسة أحواش بمختلف القبائل ممّا عجّل بنشوء فرق “احترافية” تحيي الليالي مقابل مبلغ من المال، وقد ظهرت هذه الفرق لأول مرّة في المدن [ فرقة معمورة – فرقة ئحيا بوقدير – فرقة أفا …] ثم تلتها فرق أخرى في مختلف مناطق وأصناف أحواش [ أحواش سوس: ماخفامان – أكلكال ….][ أهناقار: باني – ئزوران- شباب تاكموت- شباب ئسافن – شباب أيت علي- شباب أيت ياسين.]، ممّا أدّى إلى:
أ- تراجع تعلّم واكتساب فنون أحواش نظرا لغياب العفوية والتلقائية المعتادة لدى مختلف القبائل ممّا أدى إلى انحسار وقلة الممارسين لهذه الفنون.
ب- ظهور نخبة من الممارسين لا يؤسسون ممارستهم لأحواش على أسس فنية وعاطفية بل على أسس مادّية استعراضية صرفة.
ج – نضوب المميزات الخاصة بكل فن بسبب الخلط بين أصناف الفنون، فقد لوحظ مثلا أن فنّ أهناقار قد استقطب عددا من التعابير الفنية الخاصة بالفنون الأخرى، كما لوحظ في مجال انتشار دّرست تاوزالت أنّ الممارسين أقحموا بعض سمات أهناقار في هذا الفنّ.
2- انحراف شعراء أحواش:
في هذا الصدد لا بد من التمييز بين المتطفلين عن الذين اقتحموا ميادين الإنشاد دون أنْ تتوفر لديهم صفة شاعر، وبين الشعراء الذين تمكنوا من كفاية الإنشاد بفضل جديتهم واجتهادهم من أجل الفوز بلقب شاعر:
1-2: بالنسبة للشريحة الأولى: لا بد من الإشارة إلى عددا لا يستهان به من هؤلاء المتطفلين على الإنشاد استطاعوا أن يفرضوا وجودهم في الميادين لا بشعرهم ولكن بطريقة استمالتهم لأصحاب الأعراس ومنظمي المهرجانات، فيما يمكن وصفه بالانحراف التامّ عن الإبداع الشعري، فهؤلاء لا يتورّعون عن إنشاد كلام لا علاقة له بالشعر، لا من حيث الانضباط لميزان ونغمات الشعر ولا من حيث احترام تنسيق وتركيب الكلام وأحرى أن نطالبهم بالصور الشعرية، فما ينشدونه عبارة عن فقرات ركيكة يستغلونها في المدح والهجاء الرخيصين، وقد خلق هؤلاء الشعراء جمهورا من الرعاع المطبّل للكراكة الشعرية هو المسيطر الآن على جلّ الميادين، ومن الطريف أنّ الشعراء الآخرين يضطرّون لمجاراتهم ومحاورتهم رغم كل هذه الأوصاف لسبب بسيط وهو أنّ المشارك في الحوار من الفئتين هدفه هو ملء الجيوب بأكبر عدد من الأوراق البنكية التي يجود بها الأغبياء.
2-2: أما بالنسبة للشريحة الثانية: فقد كان من المنتظر منها أن تستمرّ في الإبداع الذي عرفت به، ولكنها مع كامل الأسف أصابها نوع من الارتخاء والانحراف لا لأنها عاجزة عن صياغة شعر جميل، بل فقط لأنّ أصحاب الحفلات والجمهور الذي تعجّ به الميادين يطالبونها بهذا المستوى المتضعضع من الشعر، وقد تتاح لها فرصة الإبداع الجميل من حين لآخر ولكن الأداء الغالب في فصل العروض الشعرية هو الانسياق نحو الشعر التقريري الخالي من الصور والرصانة اللغوية، وهو الشعر الذي تتطلبه حواريات المدح والهجاء والترفيه، ممّا يمكن اعتباره انحرافا عن دور شعر أحواش في التنوير والإبداع الأدبي.
الفصل الثالث
أزمة النقد في حواريات أحواش
توطئة:
كانت ميادين أحواش فيما قبل التسعينات من القرن الماضي فضاء متميّزا في العطاء الفنّي سواء على صعيد الأداء الشعري أو على صعيد الأداء النغمي والإيقاعي والحركي، بل يمكن القول أنّ هذا الأداء تواكبه لمسات نقدية تميّز وبكلّ جرأة الجيّد عن الرديء، وفجأة تغيّر كلّ شيء، فإلى جانب ما تحدثنا عنه عن هبوط الأداء الفنّي إلى الحضيض، سوف نلامس نفس الظاهرة في الجوانب النقدية، ومن أجل تحليل هذه الظاهرة لا بد من الانطلاق من عدد من المتغيرات التي أثرت على النقد الشعبي، مع العلم أنّ النقد العلمي النابع من الدراسات الميدانية نادر في هذا الفضاء الفنّي التقليدي، ماهي أصناف النقد المألوفة في فضاءات أحواش؟ وكيف وما هي الأسباب التي أدّت إلى تغير هذه الأصناف؟ وكيف السبيل إلى انبثاق مدرسة نقدية حديثة في هذا الجنس الفنّي؟
1- أصناف النّقد السائدة في ميادين أحواش:
1-1: النقد المباشر للكلمة الشعرية: وهذا الصنف نوعان:
أ- نقد الشاعر لزميله مباشرة: وقد لاحظناه بجلاء في عدد من الحواريات الشعرية، ومن الأمثلة التي احتفظت بها الذاكرة في هذا النقد:
+ في سنة 1979 حينما التقى الشاعران المرموقان ئحيا بوقدير والحسن أجماع بقبيلة ئدلوليميت، حدث أنّ هذا الأخير حينما اختبر أجوبة محاوره تجرأ وقال:
أر نفّرن أيليغ ئرمي أخ ؤفوس نخ
ئقان أخد أنزّاض ؤرتا تنت أكَ نفرن
لم يشعر الحاج ئحيا بأي مضض، بل تقبّل نقد زميله وردّ عليه قائلا:
هانّ أفران ن طمزين غ ئحونا نّا نّون
وانّا ياقران لحاديث ؤر راتّ أكُ ئفرن
+ وفي الأربعينات من القرن الماضي تحاور الشاعران بووزنير وعمر ؤلحانافي بقرية أكادير ن لهنا بطاطا لمدّة ثلاثة أيام، وحدث أن كرر الأول بيتا شعريا وما كان من محاوره إلا أن قال:
نغال أكزور ئس أد ئتلوح س تاقايين
ئلوحيد س ؤنخماج ؤر سول ئسّنوي يات
وقد استمرّ بعض الشعراء كأجماع وأزوليض في هذا النهج وانتقدوا ونصحوا الشعراء المبتدئين ولكن بدون جدوى فقد استفحل الدّاء.
ب- نقد الجمهور للشاعر: فكثيرا ما نسمع صيحة من أحد المتفرجين يريد بها تصحيح سياق شعري، فقد أدركنا أنّ أي شاعر يخطئ في وتد البيت الشعري [ أسقول] يخاطبه أحد من الجمهور بعبارة “تخوايك تنضّامت نّا”، وإذا أخطأ في الوزن يقابل بعبارة “ؤر اك تنمالا”، وقد يتم نقد الشاعر بسبب عدم تناسق الصورة الشعرية ففي محاورة شعرية بموسم تيمزكَيدا قال الشاعر ئحيا بوقدير وهو ينتقد رد احد المغمورين:
ييوي اك واضو تازرت لوحنت ئ واسيف
فما كان من أحد المتفرجين إلا أن صاح قائلا: “لوحنت ئ واليم أ ئحيا، ما تسكار تازرت غ واسيف؟”
2-1: تثمين الأداءات بطرق أخرى مختلفة: فإذا كانت الكلمة الشعرية هي قطب الرحى في نقد أي عرض من عروض أحواش، فإنّ التعابير الفنية الأخرى تنال قسطا كبيرا من الاهتمام، وقد أدركنا عددا من السلوكات التي يلجأ إليها الجمهور من أجل تشجيع وتثمين ما يلاحظه من الأداءات بمختلف أنواعها، وتعتبر في نظري لإيماءة نقدية للأداء، وأهمها:
أ- الزغردة والصياح النسويين: فهذا السلوك لم يكن رخيصا أو مبتذلا فيما مضى، بل لا بدّ من مبرر له، وهو الأداء الجيّد للشاعر أو الراقص أو ضابط الإيقاع، وحينما يصل أحواش إلى ذروته تنطلق الحناجر وبتحفّظ شديد من كل أرجاء أسايس.
ب- باقة الآس والزهور: [تاوشكينت] وهي باقة تتفضّل بها النساء لمن يؤدّي دوره الفني ببراعة، وقد تعدّ تعبيرا عن عاطفة مّا بالنسبة للشباب، ولكننا أدركنا بأنّ الباقة المعدة لتثمين الأداء هي الأجدر في ميادين أحواش.
ج- الوسام التثميني [ئكَيل]: وهو نمط من الإطراء يعتمد على تعليق قلائد الفضة أو غيرها من الحلي على صدور الشعراء والفنانين بأسايس، تثمينا لأدائهم المتميز، ومن أغرب ما رأيته في هذا الصدد نوع من هذا التثمين في منطقة دّو باني، حيث أنّ الأداء يتم تثمينه بتعليق أصناف من الأوسمة البسيطة على صدور الفنانين كالخضر والفواكه وقوالب عجينيات التمر وفي الآونة الأخيرة انضافت إليها قنينات المشروبات الغازية وسلع أخرى، وقد ذكر لي أحد المخضرمين أنّ أحد الشعراء تمّ تكريمه ببغلة مسرجة في عهد الاستعمار.
2- أسباب انحسار الأصناف النقدية التقليدية:
قد لا نبتعد كثيرا عن نفس الأسباب التي رأيناها والتي أدّت إلى تدهور فنون أحواش بصفة عامّة، وإضافة إلى تلك الأسباب الوجيهة نسجّل:
- قلّة الرواة: الذين يتناقلون ما سمعوه من الأشعار في مختلف المنتديات الاجتماعية، من أجل فكّ ألغازها ونقدها، ومن أهمّ ما عرف به هؤلاء الرواة أنّ باستطاعتهم استيعاب حوار شعري بأكمله، ومنهم من ينتمي إلى فئة الشعراء أنفسهم، وقد تعرّفت على أسماء من هؤلاء الشعراء الذين يمتلكون هذه السليقة الاستيعابية مثل الحسين الحسني أكرام بطاطا وإبراهيم إلياس بتاكموت، ومولاي عزيز بإرازان وغيرهم ممن لا أعرفه.
- ندرة الذوق الأدبي لدى المستمع: وقد تمّت الإشارة إلى هذه العلّة، فقد صار ميدان الأداء فيما مضى قبلة لفئة من الناس، رجالا ونساء، يستطيعون بحنكتهم النقدية فرز الجيّد عن الرديء من الشعر، سواء أثناء تواجدهم في أسايس أو حتى خارج أسايس، وهذه الفئة نادرة اليوم إن لم نقل منعدمة، بل يمكن القول بأنّ هذا الذوق انحسر بكيفية فظيعة حتى لدى البعض من الشعراء، فلم يعد المستمع قادرا على ضبط ميزان الشعر ورصد مظاهر الخروج عن التراكيب اللغوية الرصينة.
- خروج الأداء الشعري عن فضاءاته الاعتيادية: وذلك ناجم عن تحوّل أحواش إلى عروض فولكلورية بحتة، تقلّص فيها الأداء الحواري الشعري أو انحرف عن مقاصده التقليدية بتكريس حواريات تقريرية خالية من الدلالات والمحسنات الجمالية، فالأداء الذي يعرض على منصات المهرجانات أو قاعات الأفراح لا ترجى منه فائدة تذكر، لأن الهدف منه هو تقديم لوحة فنية فولكلورية لا غير، وقد ضربت عدوى هذه الفضاءات حتى فضاءات ئسوياس في مختلف القبائل، فصارت العروض خالية من الأداء الشعري الرصين.
3- هل من أمل في انبثاق مدرسة نقدية أدبية؟
في الآونة الأحيرة نشر الأستاذ عبد الحمن وادي الرحمة مقالا على صفحته بالفضاء الأزرق فيسبوك، حلّل فيها حوارا بين ثلة من المنشدين بأسايس، وأشار إلى عدد من الانزلاقات التي وقع فيها أولئك، كما لوحظ في مواقع التواصل الاجتماعي عدد من اللاءات والاستنكارات لما وصل إليه شعر أحواش من الابتذال والخروج عن الضوابط الفنية، ولكنّه وفي نفس الزمن لا بدّ من تسجيل ظاهرة فريدة من نوعها تنم عن نظرة بعض المثقفين الدونية إلى فنون الأداء الشعري التقليدي، وهي زلّة أخرى لاحظناها في مختلف المنتديات الثقافية التي أصيبت بعدوى الحداثة، فبعض الأساتذة الذين رضعوا من حلمة اللغة الأمازيغية والذين سلبتهم الحداثة ينظرون إلى الشعر الشفوي الحواري نظرة دونية ويصرون على أن هذا الشعر متجاوز.
إنّ هذه الإيماءات إلى الشعر الشفوي، سواء منها السلبية أو الإيجابية، تبشّر فعلا بظهور مدرسة نقدية، ولكنّ هذه المدرسة لا بد أن تنقسم إلى فريقين متنافرين، فريق يدافع عن الضوابط الفنية التقليدية للشعر الأمازيغي، وفريق يدعو إلى تحديث هذا الشعر والانتقال إلى الشعر المكتوب المتمرد على تلك الضوابط، ولكنّ الإشكالية الكبرى التي تستفزّنا هي وجود شريحة من مرتادي ميادين الحوار الشعري تصرّ على الابتذال وضرب ضوابط الشعر في الصميم.
إنّ الأمل في انبثاق مدرسة نقدية منصفة لجميع أجناس الشعر الأمازيغي بما فيها جنس القصيدة المنتورة، يعنمد على ما لدى أمازيغيي الجنوب من وعي ثقافي أمازيغي حقيقي لا يؤدّي إلى تحييد أي فئة من الفئات النقدية.
وحينما نقوم بتقييم نظم الشعر لدى مختلف الأنماط، فلا بدّ أن نعترف بأنّ شعر أحواش هو سيد الميدان اليوم، أمّا ما دونه فهو منحصر في نخب أصابتها القطيعة الإبستيمولوجية وابتعدت عن أسايس، وأصبحت في حالة اغتراب ثقافي فني، فشعر أحواش يستطيع في العقود الأخيرة أن يقتحم فضاءات المدن، بفضل انتشار فرق أحواش على الصعيد الوطني، ومن يتصفّح مواقع التواصل الاجتماعي اليوم سوف يقرّ بهذه الحقيقة، لذلك أعتقد أنّ المدرسة النقدية المثالية في مجال الإبداعات الأدبية الشعرية الأمازيغية هي التي تنطلق من هذه الحقيقة.
كلمة أخيرة: يجب أن لا يتبادر إلى ذهن قارئ هذه الورقة أنني أحقد على أحد، وأنا أدافع عن هذا الموروث الأدبي، كلّ ما هنالك أنني أريد أن أفتح نقاشا علميا يسير في اتجاه مسعى إحداث المدرسة النقدية، وفي هذا الصدد، أهيب بكل الغيورين على الشعر الشفوي أن ينضمّوا إلى هذا المسعى، بل أهيب بهم إلى أن لا يتورعوا عن نقد ما أنشده من حين لآخر عبر صفحات الفيسبوك من القصائد، أو ما أدليت به من الحواريات في أسايس، وأن ئدلّوني على ما ارتكبته من الأخطاء، فهذا السلوك لا يستفزني أبدا، وهذا ما أريده فعلا، أن يستمع كل منّا إلى الآخر من أجل هذه واحد وهو إنقاد شعرنا من الانحرافات والمنزلقات.
ذ.إبراهيم أوبلا 2025-08-27
المقال بصيغة PDF:
أسايس وأزمة الإنشاد الشعري وجهة نظر ممارس إبراهيم أوبلا