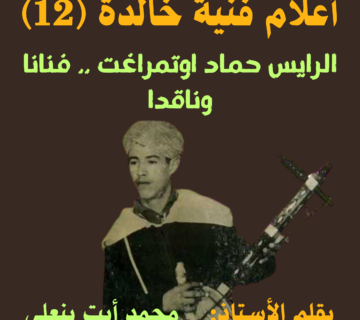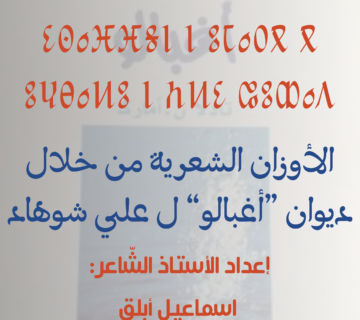- "تْݣا الموت الفرضَ لّي ئحْرّانِ"؛ ذكرى الترحم على بلبل أسايس عبد الكبير شوهاد رحمه الله-
“وانّا ساقْسان مْدْنْ مانْك آنْتْݣيتِ
آريتيني لاباس، مْقّار بْرينِ
آرِسيݣّيل إسفارن آدْجّينِ”
عبد الكبير شوهاد.
بأي أسلوب سأتحدث عن غائب عنا بجسده، حاضر بيننا بشعره وجميل سلوكه؟ بأي لغة سأعدد مزايا عبد الكبير رحمه الله، وأروم التعريف به وقد قام بذلك شعره الأصيل ومقامات صوته الجميل..؟ ومكانته بين جمهوره النبيل، ماذا سأضيف لمن أحبه جمهوره وما زال يجله ويترحم عليه..؟
أقرّ بالخجل أمامك يا عبد الكبير، وأعترف أن غاية كلماتي هذه هي الترحم عليك، وتقديم قراءة تعريفية لمن لم يتيسر له التعرف عليك، أما معارفك فمُنى هذه الكلمة أن يجددوا الترحم عليك؛ فرحمك الله ورحم كل من خلف خيرا وذكرا حسنا.
وهذه نوافذ مشرعة على الحياة الفنية لعبد الكبير شوهاد، والأمل أن تتضافر جهود محبيه لتأليف كتاب جماعي يوثق مسيرته الفنية، ويحفظ ذكره.
النافذة الأولى: فسلفة الموت: سبق مصطفى محمود لكتابة مقال عن فلسفة الموت، وكتب فريد الأنصاري
رحمهما الله عن جمالية الموت ضمن كتابه “جمالية الدين”، فاللهم اعف عنا واغفر لنا واختم لنا بالحسنى يا عفو يا رحيم.
الموت! يقول ربنا: {كُلّ نَفْسٍ ذائقةُ الموتِ وإنما تُوَفَّون أُجورَكم يوم القيامة}، وصف الرسول الكريم الموت بقوله: {أكثروا من ذكر هادم اللذات الموت} الترمذي، إنه هادم اللذات نسفا، منغص الرغبات عنفا، ومبعثر الأوراق والخطط والآمال رغما.. ! لذا قالوا “الموت لا يوجع الأموات، بل الأحياء..” فحديث الأحياء عن الأموات هو – في جانب منه – بكاء على أنفسهم وليس على من فارقهم فحسب، فهو نفس الإحساس الذي سرى في فؤاد من سمع صرخة معذب في غرفة مجاورة ينتظر نوبته، فاختلط إحساسه وتخوفه بفطرية التعاطف مع صديقه، وبخوفه على نفسه.. إن الموت يفضح فينا رغبة البقاء، ويكشف لنا زيف الحياة، ويكشف حقيقة السراب الذي ظنناه ماء زلالا، ويبعثر أوهام آمال خادعة، ويُجلي حقيقة صورة طالما رسمناها لأحلام ورتب ومفاخر ركنا إليها..
كما أنه إحساس تَولّد من برهان فطري مستكن في أعماقنا يعزز صدق الخلود الأخروي والعدل الأزلي. إنه إحساس بأن البِساط صار يسحب تحتنا، وأن الساعة ترتج إيذانا باقتراب أجلنا، وأن دقات القلب تَناقَصُ كلما ازداد عمرنا.. إنه إزعاج وانزعاج روحي يقول “أنت سائح مارّ من هنا إلى حيث الخلود” أنت لهناك وليس لهنا. أنت غريب مغترب معذب مبتلى؟ أنت نائم مسروح، بعد الموت ستصير حيا مكبلا..
دقات قلب المرء قائلة له … إن الحياة دقائق وتوان
النافذة الثانية: الموت في شعر عبد الكبير شوهاد. أسهم شاعرنا –مع إبراهيم إسكران- في إنشاء قصيدة رثاء
عزيز الهراس -رحمهما الله- أحد أعضاء مجموعة أرشاش المؤسسين، والعازف الماهر المتفنن.. وهو الذي منحته مجموعته 1999 التفاتة تكريم وترحم في عملها الذي خصصته للذكرى العشرين للمجموعة (عشرين نّوسݣاس) حين قالت:
“اللهْ إرحم عزيز آشكو ييوْساخ غّوزازو
يان إكْشمن ستاسانخ أوسارتند إيفاغ”
كما أضفى سحر أنامل الموسيقي الكبير الحسين وخاش على قصيدة “تْݣا الموت الفرض” جمالا ورونقا تناسب فيها الموضوع/ الحزن مع اللحن والنغم والأداء عموما.. وهذا دأب مدرسة أرشاش التي شبهت نفسها ب الكف/ تيديكلت، وأصابع الكف/ إضوضان.
“ݣاتاحْ زود إضوضان شْرْكات تِّيديكْلْت
الحسدا آرتاطو ويدايْمون تاسوتين”
ويقول عبد الكبير:
“إضوضان غوفوس آداك ݣانْ ديان
أُوراك نْسْميح أوانّات إيتبين”
وقصيدة رثاء عزيز هي “تْݣا الموت الفرضَ لّيحران”، وأثناء الإنشاد/ أموال والغناء تُصَدّر بلازمة (ياللــــــــــهْ يـاللــــــــــــهِ)
” يالله يالله،
يالله يالله آدّونيت مامْنك؟
إحول يان أنْمْضْلن آسْمُونس
أضونْد إرين آݣّيم إتْوْنّاس
تسانو نْسْفلدام آر تلات
أمارݣ أكْنت إهْوّْلْن تاحلت
أمارݣ نوالاخ إكّيس وكال
يالله يالله،
أورسولت أوفيخ آݣّيت نْسْموقول
أمودّو وّبادان آت ييوين
تْݣا الموت الفرض لّيحرّان
يان ميتْمّا لاجالْنْس تاويت..
أوريحكم يان آدّيرار أوسانس..
أولا آيْسْمْد إلاجال إغْكْملن..
……………..”
ولتقريب العنوان/ المطلع: ” يا اللهُ يا اللهُ إن الموت فرض مؤلم”. وتثنية اسم الجلالة في صيغة الدعاء –في اللسان الأمازيغي- يفيد التفجم والحسرة، كما يفيد الرضا بقدر الله، أي تفجم وحسرة مؤلمة يسكن المرء لهيبها برذاذ الالتجاء لله ذي الجلال والإكرام، مع تأكيد الرضا والاستسلام له سبحانه.. وهذه خاصية عميقة في الشعر الأمازيغي الأصيل؛ ستجدها في مرثية علي شوهاد القادمة، وفي قصيدة أزواݣ لعبد الكبير، وفي غيرها، وحضور التسليم والرضا يشكل بنية الشعر ويكشف جمالية الرضا والصبر والثبات، وهذا بعض تجليات ما أسماه فريد الأنصاري جمالية الموت في حياة المسلم. وسأعود للموت في الشعر الأمازيغي من خلال رثاء الشاعرين علي شوهاد وداود السوسي لعبد الكبير رحمه الله.
النافذة الثالثة: لمحة على سيرة عبد الكبير. ولد –رحمه الله- 1966 بقرية إغيل إيبركاك، قبيلة إبركاك،
دائرة وقبيلة إسافن إقليم طاطا. وإسافن وطاطا عموما تنتمي للجغرافيا التي يتدفق الشعر من قلوب أهلها تدفقَ عيون واحاتها، وتعلو فيها الحكمة والرمزية على الخطاب عُلُوّ نخلها، كبعض مناطق توبقال وتارودانت والحوز وشتوكة وغيرها، وتشهد مواسمها وأعراسها مساجلات بين كبار الشعراء، تصنع الفرجة، وتنير الجمهور، وتفضح الفساد وتصور الواقع وتنتقده وتسهم في تنمية حس وذوق الجمهور، والرقي به بلغة الشعر/ الفن والرمزية والخطاب الأصيل. كما أنها موطن الكرم، والبساطة، والجهاد ضد المحتل.. وما زالت تناضل –وعليها أن تناضل- ضد التهميش والهشاشة والأمية؛ رجاء إسقاط معادلات إعادة إنتاج التخلف والثنائيات الكولونيالية المفروضة..
وتوفي عبد الكبير رحمه الله ب إسافن 2006/23/02.
النافذة الرابعة: رثــــــــــــــــــاؤه. من المؤسف والمفارقة المحزنة أن يعيش شاعرنا عبد الكبير رحمه الله في سبيل الكلمة/ الحكمة/ الجمال المودعة في طبق الشعر عموما والشعر الأمازيغي خصوصا، ويعتلي صهوة جواد الإتقان فيه نظما وخيالا وتصويرا وإنشادا وغناء..؛ ثم لا تنصفه هذه الكلمة والشعر الذي عاش فيه وله.. إنه نكران وعقوق.. ! إلا أن الله عوضه بمحبة جمهوره وتقديرهم له؛ بما لم ينتظره من الفن وأهله والقائمين عليه؛ فيكفيه أنه شرف الفن؛ فإن لم يستطع الفن وأهله تشريف من جمّل محياهم فتلك وصمة عار على الفن وأهله. وترتفع صرخة العتاب على رفاقه في مجموعة أرشاش الذين لم يكلفوا أنفسهم الاجتماع لعمل فني تكريما لنجم أضاء فضاء أرشاش وزين محياها، وأكسبها حضوره بها مزيد ألق وتوهج ورقي في معارج الفن الموغل في أعماق النفس البشرية، ومزيد ألحان وأداء ساحر للمتلقي الذي تذوق جمال الشعر والفن الأصيل..
ومن المفارقات كذلك أن عبد الكبير –رحمه الله- حين اجتهد في تجويد قصيدة “تݣا الموت الفرض” كان يخيط قصيدة رثائه.. كما أنه ودّع محبيه وودع الشعر والفن الذي رابط لصون محياه ورفع شأنه ليقوم بدوره وهو تنمية الجمال والذوق والوجدان.. وذاك في آخر أعماله ببيت دال، أعتبره رثاء لنفسه الذي لم تكلف مجموعة أرشاش نفسها بتخصيص قصيدة رثائية اعترافا له بما قدم للمجموعة وللشعر الأمازيغي عموما. والبيت الشعري المقصود هو الذي كرر فيه بنبرة خافتة غيّر فيها – رحمه الله- المقام الصوتي فكرر:
” أيْصْحان ألحباب الله يّْهنّيكن
أيصحان الحباب الله اهنيكن”
أي : وداعا أيها الأحباب، وبترجمة حرفية: الثابت والصادق أيها الأحباب هو الوداع”
ورحم الله الدمسيري الذي تأسف على أزمة الاعتراف بالفنان الأمازيغي في قصيدته: “رْزْمحْد إيوُولي”، وتتعقد أزمة الاعتراف في الساحة الفنية إذا تذكّرنا أن أهله –الفنانون- هم أول من غيّب هذه القيمة الفضلى بينهم، ونتذكر قول أبي الحسن الجرجاني في سياق مشابه:
ولو أن أهل العلم صانوه صانهم .. ولو عظّموه في النفوس لعظّما
ولكن أهانوه فهان ودنّسوا .. مُحيّاه بالأطماع حتى تَجَهّما
وحسب اطلاعي المتواضع؛ فقد التفت لرثاء (أنفشاد ن) عبد الكبير أخوه علي شوهاد وداود السوسي بمستوى شعري يليق به وبهما، وسأخص عملهما بوقفة الآن. كما سمعت في شهادة للأستاذ الفنان الحسين آيت سي أن له عملا قصيدة رثاء له غناها مع مجموعة بإسافن، وللفنان حسن وركي ابن إسافن كذلك قصيدة بعنوان “إساول أومارݣ” غناها فقدم فيها باقة ريحان/ حَبَق لأعلام (حصون/ إݣودار) الفن (أمارݣ/ الشعر) بإسافن؛ فخص بالذكر عبد الكبير شوهاد والحاج علي بيضني، وإبراهيم… ومجموعة ارشاش بالذكر والشكر.
ويغلب على الظن أن الباحث الشاعر إبراهيم أوبلا ابن أݣادير الهنا بطاطا قد نسج قصيدة في رثاء صديقه عبد الكبير رحمه الله، لكني لم أطلع عليها بعد.
وهاك مراثي الشاعرين علي وداود:
القصيدة الأولى للشاعر علي شوهاد: (إفّين أوفوس لاجال غولينو تكات)، وهاك نصها:
” إفّين أوفوس لاّجال غولينو تَكَات
أروكان ݣيخْ إسيݣّيل تسا سْ المنشار
يُوفاتْنت يُوسيتْنْد أُورسول اخ إيشاوير
تيويت آلموت غْوادَا نْرا تِيريت تُّودْرْت
وايِريت كُويان، ربي إيرات أولا نْتّان
إيزْوارِنّْ سْرس ربي ضْرخ ساكال آر ألاخ
نعم الحكم نــــربي تْحْرّيت، ماشْ مْقّارِ
آرْقّايخ إينْفشادن سْ تاسا غ ئيلّْ أوتْرس
آرْنْشّْرك د مْدن الدّوعا آر ألاخ آر ألان
إضْرْد أوجدّيݣ الاحبابينو الروح نْ واوال
آرالّا يْجاريفن دا يْسْلان إيغ ئحوش
إسلاّو وادّاݣ ن الزيت حوسّان لموت نس
إيزّاد لقبر لجديد إمْريري ن ئسْمضال
تْنّاس تيتّݣار: حْضو غ ؤولْنيوْ لّيك إيران
أوراكّين فلخّ آتّْمْضلت غ ئلّين إيمّاتّين
……………..
آحْ آتــيتْݣار نْكّي ديم؛ ماراميتْ نْقّيس !
آحْ آياسْرير ن تْلْعينت؛ إيتْمّا واوال !
هايّاخ نْݣرادْ إمّا دارْكْ نْرات، نْراتين
ريخْ آكّ ئيݣْ مولانا غ رّْحْمْتْ نْمُوناسْنت
أورتّوخ ياتْ أتّيد إيكْتي وانّات إيتّون
دادْ نْتّيكْتاي إيغْ نݣّاور إيغْ آر نْساوال
نّيغْ تْدّا نّيت نربي س تيلاس نْواكال!
عْبد الكبير سْفْلدي نْغ يِّي تْنْغيت نْمون
تبّيت أولْنيوْ غْتوزومت نْصْ نْس مْضلن
آيْلّي دْ ݣيسنْ ياݣُورْن آراك ئيسْ آلاخ
تيغْمّار تيلي غ نْݣْمْر آيّيتن ييوين
واضّورا ݣْمْرنْت ݣيݣي، كْسْنتي والِّـــي ريخ.”
وأراها أقوى قصيدة رثائية تنافس عينية أبي ذؤيب الهذلي، ويحسن إجراء مقارنة أدبية بينهما لاكتشاف وتمييز المستوى الأدبي والبلاغي لكل منهما. وسأكتفي –في هذا السياق بالإشارة التالية:
إذا قارنا البيتين الأوليين لعلي شوهاد، ومعناهما: “رمت يد القدر بقلبي جمرا.. تفتش عن كبدي بالمنشار”.
وتمت مقارنتهما مع قول أبي ذؤيب:
وإذا المنية أنشبت أظفارها .. ألْفَيت كل تَميمة لا تَنفعُ”.
ففي كليهما استعارة مكنية تخييلية بلغت مستوى مبهرا في الخيال والترميز مع توشيحها بما يناسب؛ إلا أن طبيعة اللغة والمستوى الشعري الخيالي لكل شاعر كشف عن قدرته في رسم صورة شعرية مستقلة به.
فعلي شوهاد استعار للموت يد القدر، واستعار لألم الموت صب الجمر. واستعار للتعبير عن فقدان الأخ الحبيب قطع الكبد، وزاد التشبيه قوة حين استعمل قطع الكبد بالمنشار.. مع الاحتراس بالقدر الإلهي، الذي أشرت لمقامه في بنية الشعر الأمازيغي..
والثاني استعار للموت الأظفار، فألم ووقع الموت شبهه بإدخال الأظفار في الجسد الذي لا تنفع معه تميمة ولا حيلة.. وهي مقارنة تلفت النظر لثراء الشعر الأمازيغي، وقدرته على التصوير الفني البديع، واستقلاله ببنيته أو منظومته البلاغية والتصويرية وهذا لمن لا يعرف الشعر ب ” الكلام الموزون المقفى” ويقحم بعنف دون شعور ” الكلام العربي..” ولا يمنح هذا اللقب إلا لهذا اللسان.. ويعيش مع امرئ القيس كأنه ساقيه أو عبده، أكثر ما يعيش مع سيدي حمو.. فهؤلاء لا كلام معهم الآن. كما أنه لا كلام لمن ينشر ما اختل فيه عنصر النظم والكلام المفيد ويريد أن يسكتنا بلازمة الحداثة وكسر الحواجز متناسيا أن أول حاجز انكسر على يده هو عنصر التراكم/ التجاوز/الرمزية/ النظم والإفادة..
كما يتناص/ يتقاطع قول علي شوهاد:
” هياح نْݣّراد إما دارك نْرات نْراتين”
مع قول أبي الطيب:
وإن أَسْلم فما أبقى ولكن…… سلمت من الحِمام إلى الحِمام.
مرثية تهز كيان المتلقي باستشعار الإحساس بألم فراق الأخ، وقدرتها الفائقة على تصوير ذاك الفقد المضني بالصور الشعرية البليغة، والحقل الدلالي المناسب؛
فمن مفردات هذا الحقل: (أفوس لاجال/ يد القدر- تكات/الجمر- المنشار- الموت- إسلاو وادّاݣ ن الزيت/ يبس شجر الزيتون استشعارا منه لفراق الأنيس- تيلاّس ن واكال/ ظلمة الثرى..
ومن صورها الشعرية:
الاستعارة المكنية الموشحة: وهي أعلى مراتب الاستعارة لكون التشبيه والتصوير الفني فيها طُوي ذكر المشبه به، ورمز إليه بأحد لوازمه، ومن الناحية الفنية التصويرية فمقامها يتجلى في عبقرية التخيل والتعبير الموغل في الرمزية والتعبير الذي يسحر المتلقي. ومن ذاك قوله:
” إفّين أوفوس لاّجال غولينو تَكَات
أروكان ݣيخْ إسيݣّيل تسا سْ المنشار
يُوفاتْنت يُوسيتْنْد أُورسولاخ إيشاوير
تيويت آلموت غْوادَانْرا تِيريت تُّودْرْت..”
فقد مرت الإشارة أنها تقارع المثال الشهير في مرثية أبي ذؤيب الهذلي، مع تأكيد بلوغ هذا التصوير من علي شوهاد مقاما عاليا لم تصله الأخرى: فتأثير القدر صوره ب “يد القدر”؛ صبت يدُ القدر في قلبي جمرا.. وألم الفراق وصدمته صوره باستعمال يد القدر/ الموت وسيلة ثانية بعد الجمر وهي التفتيش عن كبده بمنشار، ثم قلعها بتلك الجرجرة المضنية دون حنين ولا استشارة.. وجاء علو هذا التصوير والاستعارة المكنية الموشحة بتشبيه أخذ الموت قريبَه بأن يد القدر –بعد صب الجمر في القلب- شرعت تفتش عن كبده بالمنشار؛ ومعلوم أن الكبد –في المخيال الأمازيغي- رمز لأعز ما تملك، ومكمن الوداد والوفاء.. واستعمل المنشار لتصوير تلك الجرجرة والغرغرة التي أحدثها الفراق؛ فليس قطعا بسكين حاد؛ كعلاقة عابرة أو فراق ينسى؛ بل فراق مؤثر لا ينسى.. وهو كذلك رحمه الله..
ثم سما علي شوهاد لمرتبة استعارة وتصوير بليغ فلمّح لذبول شجر الزيتون الذي اعتاد الشاعر أن يخلو فيه تأملا وبناء لصرح إبداعه الشعري.. ولتصوير مكانة الشاعر بين قومه ومحبيه: ذكر البكاء المشترك
“إسلاّو وادّاݣ ن الزيت حوسّان الموتنس”.
كما ألمح لمكانته الشعرية في أسايس والغناء بالآلات بقوله:
“آحْ آياسْرير ن تْلْعينت؛ إيتْمّا واوال !“
وقصد الالتفاتة لهذا الاعتبار، وهو مكانة المتوفى بين معارفه، ومنزلته في أسايس والفن عوما؛ جاءت مرثية داود السوسي بمدخل تصوير حزن وذبول وسكون البستان؛ “تورتيت تْمدوديت آركا تالامت..”، وسأقف عندها لاحقا.
وأتوقف هنا مكتفيا بهذه التلميحات لهذه القصيدة التي ترشح ألما وجمالا وتصويرا شعريا بليغا، وتكريما لهذا الشاعر
القصيدة الثانية بعنوان: مامْنْك راكْتّوخ؟/ كيف سأنساك؟ ومما ورد فيها:
“مامْنك راكتّوخ أوالييّْ
ئݣان نݣت نكين
متا تݣا تودرت ئيرطال
نْبْضو ديدك أوسّان
إرا القدر أدّْ نْمّيقير
ئبضوياخ واياض”
وفيها استعارة وصورة شعرية عميقة وهي قوله:
“لاح كولو مادّ ئخلّون
آلبرج آبلا كييّْ
تايْدرت ن واجيݣ نون
آلغلباز تاسوس”
فقد شبه موته ببرج عال تهاوى؛ وهو كذلك؛ فمعارفه يؤكدون أن الشعر وصدى أسايس خمدت جمرته في إبركاك ونواحيه بعد موت عبد الكبير رحمه الله.
ثم أضاف لهذا المغزى أن سنبلة وردة (لغنباز) تناثرت في الأرض. وعذرا عن عدم القدرة على تحليل هذه الصورة الأخيرة، فهي من النوع الذي يتلقاه الذوق مع العجز عن صياغته. وكل الشعر هكذا أصلا.
وفي قوله:
“أورتوفْت ويلي إيزرين
أورك إيشابها يان”
لست كمن سبق، ولا يشبهك أحد! تشبيه بليغ زاده بلاغة توشحه بفن الاحتراس الذي أخرج به شعرة الكبر والافتخار الذي قد لا يستسيغه المتلقي، مع إبقاء الفقيد في منزلة عالية جسّدها عدم النظير. يقارن هذا بقول الخنساء -رحمها الله- في رثاء أخيها صخر
ولولا كثرة الباكين حولي … على إخوانهم لقتلت نفسي
وما يبكون مثل أخي ولكن … أعزي النفس عنه بالتأسي.
فعلي شوهاد –كما سبق- استطاع أن يمدح أخاه دون الوقوع في تفضيل مستغرب قد تنبعث منه رائحة افتخار وتفضيل غير مثير؛ وأداته في ذلك فن الاحتراس مع مدخل إبراز التميز بعدم النظير؛ بينما الخنساء سلّت نفسها –بعدم قتل نفسها بكثرة من يبكي حولها على فقد الأحبة؛ وقد أشرت إلى أن التسلية في شعر علي شوهاد وأخيه وغيرهما من كبار الشعراء يرسمها الرضا بقدر الله؛ ونعذر الخنساء فربما صدر منها هذا القول قبل إسلامها. وما يهم هنا أنها وقعت في تفضيل أخيها –مع حقها في ذلك طبعا، فهو يدها اليمنى في نوائب الدهر- على غيره؛ فكل الباكين لا يبكون مثل صخر؛ بينما استطاع علي شوهاد أن يفلت من هذه المطبات والحفر المزعجة. وبقي التأويل لك أيها القارئ، فغايتي الإثارة.
القصيدة الثالثة للشاعر الباحث داود السوسي بعنوان” أنفشاد”/ الرثاء أو العزاء. وهذا نصها:
” تورتيت تْمدوديت آركا تالّامت
كْراد ڭيم ئسّاڭّان ئِيخف ئِسْ ئِمْرّت
نّيغ ماسّْرم ئِڭ لْحال، ماكّْم ياغن
زيغْد أنْبداد نْم أكُّنْت ئِفّوغْن
أنّيغ نيت ئِڔيژ ڔْعين غ ئِسورا نْم
أنّيغ نيت أجّيڭ نْم أور سول ئسّوسم
د ئِڭضاض لّي ڭيم ؤُرا تّيريرن
أيهايّا، تيڭيرا ن ئواليون
ئلّي غ ڭيسنت نْڭّومّي ماسْ نْتّينيْ
ئِلْس ئڭا أزنزوم، ؤرا ساوالن
مان أنفْشّاد ئِليقن أتّْن نّازن”
إي “تيتڭار” أتْند إيفوغ واطّان نْس
مان أنفشاد ئليقن أتن ناوي؟
إيا يْڭان أماضون ئغ ت إيفل وينس.”
صاغ الشاعر قصيدته الجميلة هذه باستشعار حال أسايس والشعر بعد عبد الكبير؛ فتخيل لذلك بستانا جعله مخاطَبه مستفهما عن حاله الكئيب وكثرة بكاء ما فيه؟ وتغير مياه معينه التي امتزجت بالطين فتعكر صفاؤه.. فوَرْدُه ذبل، وطيوره مغتمة توقفت عن التغريد، والشاعر نفسه التصق وجمد خياله..! ما يعني أن حدثا مؤثرا ووضعا مزلزلا وقدرا إلهيا قد جرى، وهنا خلص بالإحالة لمغزى حزنه بذكر لفظة “تيتْݣار” وهي القرية التي أحبها عبد الكبير وأنس بواحتها وزقاقها، وأنست به كذلك فآلت –كما صور علي شوهاد في القصيدة الأولى- أن لا تسمح لثرى آخر بضم رفاته.. وختم داود باستفهام مفحم مفاده: أي عزاء ورثاء يناسب ويليق أن نحمله لذي ضنى تركه من أحبه؛ وما قصده إلا نفسه؛ إلا أنه اختار هذا الاستفهام والتشخيص في خطابه الشعري إعلاء لبلاغة قصيدته..
النافذة الخامسة: المكانة الفنية لعبد الكبير. وفيها محطات وزوايا منها:
تجربته مع مجموعة إزماز: قبل التحاق عبد الكبير بمجموعة أرشاش -خلفا لعزيز رحمهم الله- كان عضوا
بمجموعة إزماز الفنية الأمازيغية مع بليازيد وآخرين، رحم الله من مضى وبارك في من بقي. ولهذه المجموعة بصمتها الذهبية على الفن الأمازيغي/ المغربي الذي تنافس به غيرها كأرشاش وإزنزارن وغيرها.. فقد أبدعت شعرا وألحانا وأداء، وبعض أعمالها لاقت شهرة وتردادا من طرف فنانين آخرين ثمانينات وتسعينات القرن الماضي، وهذا نموذج عمل فني لإزماز؛ يصور عمق إبداعها الفريد بأداء عبد الكبير والمجموعة، والغالب على الظن –لمن يعرف شعر عبد الكبير وشموخه في علياء الشعرية بالتصوير الفني الفريد تشبيها واستعارات وكنايات وغيرها، وتميز غزله بالروعة والجمال- أن القصيدة لعبد الكبير. اختارت لها المجموعة عنوان “تجْماكْت” وذلك أن بحرها (أسيف ليغتّاونا) ولحنها مستوحى من بحر أجماك ونمطه في فن أحواش. مطلعها:
“تاتّويْتاح البْـرج إيغايكْ نْسِّيوْن
تيط آردْ رْميخ نُادّاسنت سيكالن
نْݣّامي وْلَا آداخْد إيبان أوݣفافنك
أَ والّي مو كّيخ ݣيݣان أور سول نْسْن
إسْيي ݣيون إيلّا الحُب أولا ئس يك ئفل
آحْ أتابرات أورتوضيرت أور تْلكيمت
تامازيرت نسوس غيدا غيلا وينْوْ
رْميخ آسمامي رميخ آكّاساوالخ..”
(رابطها في الفيديوهات المرفقة أدناه)
تجربته مع مجموعة إبركاك، بمعية رفيق دربه عضو مجموعة أرشاش إبراهيم إسكران. فمجموعة إبركاك
أسسها إبراهيم إسكران عضو أرشاش، أشرك معه في أعمالها مجموعة من الفنانين أذكر منهم: (الحسين وخاش، المحفوظ كويو وعبد الكبير رحمهما الله، الحسن حطمات، والمنادي من آيت عبلا وشباب آخرون أعتذر لهم لكوني لا أعرف أسماءهم، مع الاعتراف بمنزلتهم الفنية)
انضم عبد الكبير لإبركاك تسعينات القرن الماضي وتعاون على إنتاج شريط غنائي سجلته “صوت المعارف” بعزف “الحسن حطمات” وتعاون فنانين آخرين في الأداء. من قصائده الراقية: “أزواݣ”/ الغربة. فقصائد وألحان هذا الشريط متناغمة أضفت على عمل المجموعات رونقا وبهاء.. فإذا اجتمع عبد الكبير مع إبراهيم اسكران يحلو النغم، ويعم الأنس، ويهتز الوجدان، وتتفتق الألحان متناغمة مع موضوع القصيدة. ولك دليلا على هذا شريط “تݣا الموت الفرض لمجموعة أرشاش، حين انضاف له نجم آخر هو الموسيقي الحسين وخاش.
والشريط الذي فيه قصيدة “أزْواݣ” لإبركاك قصيدة صورت بريشة الشعر وأحاسيسه التي تهز وجدان المتلقي مأساة غربة أبناء البوادي ونضال الصبر ببادية لا يسعف حرثها وكسبها في تحقيق عيش زهيد. ففكرة القصيدة تصوير أزواك/ الغربة/ الهجرة/ أو التغريب بأن الشاعر اغترب عن أهله وقريته ليس هروبا من قتل أو سرقة، بل لشظف العيش، ومشقة الكسب والحرث التي نتقاسم معها ما نملك، وصّور بتصوير بليغ مأساة عدم جدوى كسب وحرث أغلب بوادي سوس بأننا حرثنا؛ لكننا نشتري التبن للدواب، ومن عبقرية تصويره الفني لتلك المأساة وتهافت معيشتها؛ ذكرها شجر الخروب والوادي معا بالتصغير، فلا تخال أن لنا واديا كدرعة أو سبو، ولا تحال أن لنا خروبا وغيره يمكن أن يرفع مستوى معيشتنا؛ ينضاف لذلك أن الوادي جرفه وأوشك أن يقتلع جذوره؛ إنما منحه الأمان حياء.. ما يعني أننا في رحمة الله لا غير .. ! وينسحب هذا التصوير على إنس هذه القرى.. !
ورسم آهات المرضى والحوامل في انعدام المستشفيات ولوازم التطبيب.. لكنه لم ينس التعلق بالأمل في الله لتخفيف الألم والقدرة على المواصلة..
” نْلاّ غوزواݣ أورنْغيح يان أوراس أوكْرخ
دارنخ آنرا اݣّيس نݣّاوْر؛ إساس أوروفيخ
إميك ن تكيضا لي ݣيس غِ ئميك ن وّاسيف
إفكياس لامان نّربي اور ئرا آتْنت آوين
إما هان تاكوف، لْبين ومان آكال نس
لوقت ن ؤنزار إݣيݣن كا أسّول إيتّيلين
نيلي غ لخريف كراض ئيرن، آرْ نترفوفون
نْكرز آرداخ نْسّاغ ئ لخلاييق آليم
أوكان ئنْكر بداݣينخ إمال، آرْ إمال
نْݣن رّجانو غ ربي وْرْ نسول أور نموت
أور نسن سبيطار، مدن طافن يان إيان
أولا اضبيب رب آدّ ئتسلاكن لمسلت
………….”
ومن الحكم والمعني المؤثرة -وما أكثرها- قوله: “الهم إزْمْزل واضو آوريرين اسفار”. فجانبها الشعري يتجلى في فن التعبير وهو “..إزمزل واضو..” وجانبها الفكري العقلي الواقعي يتجلى في الإشارة إلى كون قضايا وهموم المناخ أشد أنواع الهموم تأثيرا؛ فهو من أسباب أزواݣ/ الغربة.. وقد تكلفت البرامج الوثائقية في إبراز “فوضى المناخ”، وهذا التعبير الأخير عنوان كتاب مترجم نشرته عالم المعرفة بالكويت..
عمله المشترك مع الفنان الحسين وخاش: حيث أصدر مع مروض البانجو الموسيقي الكبير الحسين وخاش
الذي صاغت أنامله نمط أرشاش أو ترشاشت الموسيقية؛ عملا فنيا مشتركا بعنوان: “آيت أومار” لعبد الكبير كلماته وتعاونه في التلحين، وللحسين التلحين والأداء الموسيقي/ البانجو.
مساهمته في مجموعة أرشاش: خلّف عبد الكبير عزيز الهراس “رحمهم الله” في عضوية مجموعة أرشاش
1996. فأضفى على المجموعة رونقا وشجى وشجنا.. وكان استفتاحه في رحاب المجموعة عملا فنيا مدويا، يشهد بذلك ألبوم “تْݣا الموت الفرض”، ومن قصائده: “إݣودار إيݣودار..” و “إبّاقا يِݣيݣ..”، ويكفيه فخرا أنه أضاف لأرشاش جمهورا جديدا، وهو “الأنثى/ الفتيات” ولا يعني هذا أنهن لم يكن يطربن لأرشاش، فالجغرافيا التي استحوذ أرشاش على ذوق جمهورها كطاطا إسافن إبركاك ايت عبلا ضواحي تافراوت إفران؛ يتابع فتياته وغيرهن إصدارات أرشاش قبل التحاق عبد الكبير بها. خاصة حين وظف ألحان أحواش.. إلا أن قصدي أن ألبوم “تݣا الموت الفرض” وبعده “عشرين نّوسكاس” و “أبوه الهنا” وفق ما عشته وأنا صغير إبان صدورها أطربت؛ بل أبكت ورود القرى، وكن يرددنها في جمع العشب فصل الربيع.. ومن مفاتيح سحر ذاك الشريط الصوت العندليبي الذي حبا الله به عبد الكبير.
إذن لعبد الكبير فضل كبير على أرشاش، ولا ينكره إلا جاحد متكبر عديم الاعتراف والضمير. أقول هذا بمسؤولية لأننا سنلحق به في دار الجزاء. كما أن لأرشاش فضلا على عبد الكبير كذلك؛ إذ أسهمت في صقل موهبته، وشحذ مستواه خاصة في المجال الموسيقي، ومواءمة الأداء الغنائي للمستوى الموسيقي المناسب؛ وفي هذه الخاصية اختل الميزان للكثيرين..
ومن الأشرطة التي برز فيها كوكب عبد الكبير وسحر صوته: شريط عشرين نوسݣاس كقصيدة ( أبوه الحنا). وقصيدة: (الورد د الغلباز إلوحن آيّاو) وقصيدة: (أزمز ن قضي غراض أوت آفوسنك- أيادّيلكمن آلجاهيل آور نْتّاحل)
وهنا ملاحظة: إرث عبد الكبير في مجموعة أرشاش بحاجة لفريضة تبين نصيبه، فالله والتاريخ حسيب رقيب. نعم لا أعرف تفاصيل الأنصبة؛ فما أنا إلا أحد متابعي المجموعة الذين يقرون لها بالفضل والتتلمذ وتصقيل الذوق الفني واللساني فجزاهم الله خيرا، كما أني متابع من درجة باحث صار جزءا من هذه الاسرة يحق له أن يسأل ويقترح؛ فأرجو أن تتسع الصدور وتصخي الآذان.
هناك أعضاء ماتوا رحمهم الله، وبقية خلف بيننا حفظها الله، فعليهم أن يتعاونوا في كشف هذه الحقيقة تمييزا للأنصبة والإرث الفني والقانوني لعبد الكبير ولغيره؛ فيكفي أن هؤلاء نذروا حياتهم لهذه المجموعة؛ فأقل الاعتراف وإسداء الجميل أن يتعاونوا –بصدق- في إبراز تاريخ المجموعة قبل أن تتلاعب به ظنون النفوس والتاريخ..
والقصائد التي أشرت لها زادها عبد الكبير رونقا وجمالا بحسن أدائه، ومقاماته الصوتية، وفرادة غنائه لها، علما بأن النسبة الكبير من شعر المجموعة لعلي شوهاد حفظه الله.
كما أصرح بأن عبد الكبير أطعم الإنتاج الشعري لأرشاش بشعره، ومن يعرف شعر عبد الكبير ويتذوقه يلمس أثره في شعر المجموعة. وبقية التفاصيل أسكت عنها في انتظار كشفها من قبل الأعضاء المنصفين والمتابعين الذين هم شهود عيان على تاريخ المجموعة..
أعماله الفردية: لعبد الكبير أربعة أشرطه
أولاها: سجلها عند “بيجديݣن” ومن قصائدها:
“أرالاّ يْضوضان، أطّان إيلا غوفوس”
أرالاّ يْزوران؛ يوضن وول إيݣلين
………………….. “
أي: تبكي الأصابع والألم بالكف. تبكي العروق؛ والضنى بالقلب المسكين… تصوير بليغ لحدث مفجع علّه وهج الحب بقلبه..
وقد شارك معه في عزف هذا العمل الحسين وخاش.
الثانية: هي التي عنونها ب “عبد الكبير أزْمْز”، بتعاون الحسن أوسالم أحد أعضاء إزماز، عازف الرباب والعازف عبد السلام مامز. ومن أبياتها:
” نْلاّ غودرار أورت إعمّر يان
مندون إقلالان نع إيبْنكالْن
إݣّامي وْغراس آݣّيس إيفغ
والّي ياد ݣيس؛ إݣيݣ آت إخلان
…………
أباب إيكْروان د ئزمّارن
آر ئسّا غ وتاي واد إميمن
آيليغ نيت إزْنزا تاوْروت !
آرِ ئساقسا: ميّاغن لوقت؟
……………..”
ويرجعنا هذا المقطع لنضال عبد الكبير لصالح أدرار/ الهامش، وتحوله لصادح صارخ بمأساة أهله، ومعاناتهم.. كما مر في “أزواݣ”. ومن قصائده ذاك الشريط كذلك:
“العاقل إغيلا دار يان آيݣْمّين
أراقران، أرِسّاقرا يان ديمون
………………..”
وأعمال هذا الشريط غير منشورة في وسائل التواصل مع الأسف، نرجو ممن يملكها العمل على نشرها.
الثالثة عنوانها: “تاصومعيت”؛ تسجيل وحمان كاسيط، هي والأخيرة “أمودو الهوى”. ومن قصائد شريط “تاصومعيت: “
أتاصومعيت أنّ ن نݣر ييتران؟
ماني غ ئغلي وابريد نونت
……….”
وقصيدة:
“إݣراد إلمّا ايْستنْزامت آتاجداعين
تْفلمت آزغار إيݣلين؛ إزران آسعمرن
……”
الرابعة: قبل وفاته –رحمه الله- بزمن يسير، عنوانها ” أمودو الهوى”
من أعمالها: قصيدة في وصف بعض قرى وقبائل طاطا وسوس بسياحة فنية؛ “أمودو الهوى”، وقصيدة عن تصوير مأساة الهجرة لأروبا وما يعانيه روادها من مشكل المغامرة في غياهب ظلمات البحر ومخاطره، وتصوير الحالة النفسية التي تعتري من يفكر فيها بربط مستقبله ومبادراته بالهجرة.. ثم قصيدة عن تصوير وضع الفن والشعر الأمازيغي؛ إذ سقط النقد واستبدل بالمحاباة…
وكل أعماله ذات جودة عالية شعرا وألحانا؛ يغلب عليها الاستثمار البديع لألحان أحواش؛ بمعنى استثمار لحن متداول. وفي الغالب إبداع لحن آخر تتلقفه آذان فتيات أحواش ويغنين به؛ وهكذا أرشاش التي ترش الأرض فينبت الزهر وتتطاير العصافير والنحل في ربى سوس والحوز والأرجاء كلها..
النافذة السادسة: موقعه في أسايس. ربما أسايس أو شعر أحواش هو الحلبة المفضلة للشاعر، يبادله
العشق والأنس، فصار بدرَه المنير، وجواده الأصيل. ويعتبر شعره امتدادا لشعراء أسايس القدامى، مع بصمة التميز الإبداعي، فهو شعر يغلب عليه إحياء القيم وتنميتها، قيم الجمال والحب والوفاء والرضى بالقدر والنضال لصالح أدرار والهامش عموما، والغزل الموشح بالترميز المتدثر بالحياء، المصوغ في قالب العاشق المتيم، المترفع بعزة النفس والوفاء، مع عشق الطبيعة والقرية، وتصوير قساوة العيش بها، وظاهرة الهجرة للمدينة والهجرة السرية، مع شعر الدعابة والسجال الرشيق للتنشيط والإثارة..
وله بصمة فريدة على نمط “تامسوست”، عرّف الشاعر الباحث داود السوسي هذا النمط بأنه: ” تامْسّوست/ أمْسّوس: من فعل (إسُّوسْ) الدال على النَّفض، كنفض الغبار ونحوه، واستعيرت اللفظ لهذا النمط الشعري/ الغنائي لما فيه من عملية الإلقاء مع الالتقاط كما سيظهر في تعريفه، وهو مقطوعة شعرية قصيرة يتفنن الشاعر في إلقائها بألحان شجية، يختار لها موضوعا ووزنا مناسبا لنوع الرقصة، ولطبيعة الموضوع ومغزى تدخل الشاعر صاحب (أمسوس) إن جاءت بعد حوار. فيردد راقصوا أحواش آخر بيت وحده، أو مع لازمته إن كانت له لازمة.. وهي موجودة كذلك في أحواش الخاص بالنساء، غير أنهن لا يرددن آخر بيت فقط، يل ينسجن على منواله ردّهن على مُلقيها بالترحَاب أو بما يليق به وبالمقام.” من كتابه: (أسْقُّول في الشعر الأمازيغي بسوس وعروضه، داود السوسي. 12 بتصرف. ولم يزاحمه في المرتبة العالية لإتقان فن تامسوست إلا صديقه امحمد أݣرام عفا الله عنا وعنه، ويأتي بعدهما الفنان الهاشم آيت وحمان. فمع وقفتهما يعم الصمت وتعم القشعريرة من تذوق الشعر وألحانه، وقد صار كثير من الشباب الذي شرع يلج عتبة الشعر يسير على خطاهما بنوع من التقليد المحمود، ما يعني أن عبد الكبير مدرسة شاءت قدرة الله أن تغلق أبوابها بسرعة، لكن الوفاء والمحبة له هيأت أسباب تداول مقاطعه وتمليها..
ومن نماذج هذا النوع لعبد الكبير قوله حين صوّر ما يفعله أرباب كل ميدان بمجالهم هدما وإهانة وانحطاطا به؛ فقال:
وايـــــّـــــــــــــــــــــــه، أللآيْل أللآدلالِ.
وايّــــــــــــه، إغنجاون لّي تّآݣْمنينِ
وايّــــــــــــــه، أتِكينْتْ أكْنت إيضرّانِ
وايّـــــه، ونّا ݣيم يوݣِمْن إيغ رمينِ
وايّـــــــــــه، إيفْل داخ تاولا ݣيوْنْتِ
وايّــــــــــه، إيفْل داخ تاولا ݣيوْنْتِ
وايّـــــــــــه، إويلي كْنْت تّْرْزّانين.”
وهنا شبه المجال الذي استوجب من أهله صون حماه، وحفظ محيّاه، وإعلاء صرحه وبناه؛ شبهه بقدر تتناوب المغارف التي تستقي منها على كسر جدرانها؛ كلما استقى مغراف ترك كسورا ورضوضا، وجاء بعده شبيهه تباعا.. وبالغ في هذه الرمزية العميقة؛ ما يمنح المقطوعة صفات الشعرية العالية، وللمعنى إمكانية الإسقاط على كل مجال أفسده أهله؛ كالفن والإعلام وتدبير الشأن العام وتسيير المؤسسات والمقاولات ..
وقوله:
“رْزات آسْكيون ديجْنوين
آدّاغ أور ييلي مادّْ نْتّاحل
آجّاتاغ د الهوى دومارݣ
أسْرس نتداوا تيݣّاس ئنو
آياك آسف ن سّوق نْعمرتن
آكويان مايسّاغ إيسنت”
مقطع فيه إعراض وتجاوز للسجال العقيم، وتجاوز لحال النفوس المسكونة بجمع المال وعقدة الرفاهية، فأعلن “مذهبه” وهو العزلة والقناعة والكفاف، مع الاستئناس بالفن الذي يسلي به؛ وختم بصفعة مدوّية تبين اعتزازه بذاته وقدره ورزقه –فليس من النوع الذي يأكل النعمة ويلعن الملة كما يقال- قائلا: كلنا نجتمع في السوق؛ فليس لكم ما تتباهون به علي..!
ومما حفظته على لسانه وقررت أن أجعله شعاري:
“أهان أورا نْزْمْزي يان أوراس أوفيخ
ماش أورْ نْحميل طّنز؛ إيغ رات إسالا يان”
أي لا أحتقر أحدا، وحاشا أن أكون كذلك؛ كما أني لا أقبل أن يحتقرني غيري. وهو شبيه بقول الخليفة عمر رضي الله عنه “لست بالخِب ولا الخب بخدعني؟
سابعا: نافذة الختم. عبد الكبير رحمه الله شاعر له بصمته، ولشعره وصوته روعته، ولفراقه لوعته؛ فليس
مجرد نسخة مكررة، بل هو ابن أسرة شاعرة، وذو لمسة جمالية فنية بديعة؛ فأبدع في الألحان، والمقامات الصوتية، مع صوت ذي نغمة فريدة له وقعه وشجنه وتأثيره.. وبعض المقاطع الموثقة باليوتوب شاهدة على ذلك، والإبداع في الألحان والمقامات الصوتية تميز فريد لعبد الكبير ولغيره من أعضاء مجموعة أرشاش.
كما أبدع في النفس الطويل الذي قل أهله في شعر أسايس الذي يغلب فيه شعر المقطوعات القصيرة، وهي ميزة صارت له ملكة بسبب الاشتغال على سبك القصائد ولحنها، سواء ما اشترك فيه مع شعراء مجموعة أرشاش، وأذكر منهم علي شوهاد، وابرهيم اسكران. أو ما نشره باسمه فقط..
تميزه بالتواضع، والحب المتبادل مع الجميع، فعبد الكبير يشهد له من عاشره بالتواضع والنبل والزهد؛ فحتى لما اختار أن يقضي أغلب وقته في مسقط رأسه إبركاك وإسافن؛ مخصصا حياته للفن.. لم يكن –مع صديقه امحمد أݣرام الذي كثيرا ما اجتمعا في مناسبات المنطقة- يساوم على المال رغم حقه في ذلك، فتواضعه وزهده وهوايته الفنية جعلته كذلك؛ ما منحه محبة جمهوره له. وهذا دأب شعراء أسايس قبل الاحتراف والنجومية الحالية؛ فالثلة التي كان عبد الكبير يجتمع معها بأسايس ويطرب معها هم الحاج علي بيضي، الحاج الحبيب ݣويميتك، محمد أساكني ݣويبركاك رحمهم الله، وامحمد أݣرام عفا الله عنه، والشاعر الباحث إبراهيم أوبلا. وغيرهم طبعا.
بكتك يا عبد الكبير ليالي إبركاك وإسافن، واستوحش لذكرك فناء أفرني، وذبلت لفقدك واحة تيتݣار، وبكتك القصائد الموزونة، والقوافي الرنانة، والمعاني الأصيلة، والألحان الشجية، والأفئدة المتيّمة الوَلِهة.. وصار شعر أسايس بعدك مهجورا، وبعض أعلامه متكبرا مستبدا ب “الميكروفون”؛ لفتا للانتباه واستئثارا بالغنائم، واستحوذت عقدة النجومية والثرثرة، متناسين واجب الإتقان وجميل التواضع وأمانة تسليم المشعل لمن سياتي.
ومع التذكير بالخجل أمام سمعتك ومكانتك، فتقبل تطفلي وفضولي الذي دافعه محبتك، وواجب رد الجميل إليك؛ فقد أسهمت –مع أرشاش- في تشكيل خيالي الأدبي، وتحبيب الشعر الأمازيغي إلي، وتذوق جمال لغتي وخصوبة ثراء معانيها.. أرجو أن أقوم بجزء من الواجب، وأن أخفف ألم الفراق الذي يراودني، ويراود جمهورك الذي ما فتئ يذكر بيوم فراقك. وأسأل الله أن يغفر لك ويرحمك، أنت وكل من خلف ذكرا جميلا.
وتحية شكر للباحث الشاعر عبد الرحمن واد الرحمة الذي تفضل بمراجعة هذه الورقة ومدي بمعطيات وتصحيح أبيات. فله ولمدير مدونة أسكيل الشاعر الباحث داود السوسي الشكر والوداد.
بقلم: حسن اهضار،
مراجعة: عبد الرحمن وادالرحمة.