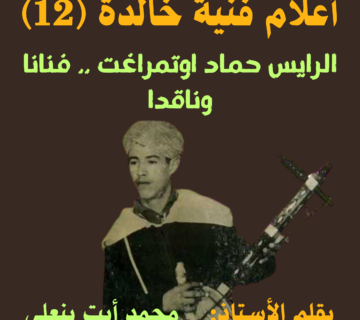حديث الهوية في أغنية لبوشارت " تيقبورين"

عرفت حسن وار ݣي ومجموعة لبوشارت عبر الشبكة. كنت على الدوام من الباحثين عن إبداعات أرشاش وإنتاجاها شعرا وعزفا وحوارات، فقادتني الصدفة إلى أشباههم ونظائرهم إن صح أن في عالمنا وفي عالم الخوارزميات شيئا متروكا للصدفة.
لقد كنت وأنا طالب بأݣادير أرى في مجموعة أرشاش ملوك الشعر والموسيقى، ولم أشك يوما في هذه الحقيقة الجمالية حتى أن طاطا القريبة من قلبي والتي لي في أصدقاء ومعارف كانت تتراءى لي مملكة للشعر والنغم الجميل الهادئ وعلى عرشها ملك متوج هو علي شوهاد. تزامن ذلك مع قناعاتي حينئذ بحاجتنا إلى فنون تأملية عميقة. كانت فنون الكلمة أقرب شيء إلى تحقيق الصفة التأملية والعمق التاريخي والنفسي الذي كنت أصبو إليه متأثرا بالتعبيرية في الأدب. كنت أرى ذلك بديلا للصخب وللسعادة التجميلية والفلكلور الميت. أراني شخصيا أحلم بالقصة القومية والقصيدة الوطنية واللغة الكثيفة الرمزية، بينما كان الجمهور من حولي يرون في الموسيقى طريقة في التنشيط واستدرار الدوبامين وإلهاء النفس والتعبير عن النوازع المختلفة. أمر مساء بين حلقات كثيرة وأرى فرقا طلابية عديدة تتشكل في الميدان وتشخص الفولكلور القروي الميت، تحاول به التماسك بين أمواج التحديث الحضري وأمواج المد الأيديولوجي الكاسح والغربة القاسية. لاشك أن من يراهم يشعر بالنيابة عنهم جميعا بقسوة التعبير وصعوبته. عرفت في هذه المرحلة النقد الأيديولوجي عبر كتب الدكتور عبد الله العروي واقتنعت بجدواه في بناء الوعي التاريخي ودوره في بناء الفرد وإصلاح المجتمع. قدرت مع ذلك الأيديولوجيا وأفكار المناضلين لكونها وكونهم نوافذ على الوعي الشمولي بحركة التاريخ. الأيديولوجيات جزر أرخبيل كبير. الأيديولوجيا في بيئتنا وعي منشطر يجب توحيده واستجماعه كأعضاء جهاز فيزيولوجي فرقه المرض. سبب الانشطار هو التمايز الطبقي أي تشكل الطبقات الاجتماعية في المجتمع المعاصر -غير الحديث- بعد الإصلاحات الاستعمارية. الاستعمار المعاصر هو لمسة الطبقة البرجوازية الكبرى خارج أوربا.
يطلق المصلحون اسم الحداثة على مجموع الإصلاحات التي يجب القيام بها لدخول العصر الحديث بغير طريقة العولمة الثقافية والاقتصادية التي تنتشر الان في أصقاع العالم بسبب تمدد الشركات والاتفاقيات والاتصالات الرقمية وتأثير الإشهار وبرامج التنمية ويدخل في هذه الحداثة الإصلاح الديني والثقافي والثورة الصناعية التقنية والدمقرطة السياسية. كنت أرى وهذا في الحقيقة رأي غيري أن القيام بكل هذا سيحول طرق الإنتاج وطرق التفكير وسبل الإبداع كما حدث في أوربا على مدى ثلاثة قرون. في هذا الوقت كنا نرى حاجة المجتمع الماسة إلى إحراز هذا الوعي وحاجته إلى تجاوز الوعي الأيديولوجي العلمي والديني والقومي والسياسي لتسريع ميلاد الوعي التاريخي الشامل بوضعية المجتمع. في مجال الإبداع الفني انتظرنا تفوق التجديد على التقليد والفلكلور وتأسفنا لأن التجديد لم يستطع أن ينجز إلا ما استطاعت حركة الحداثة البطيئة أن تنجزه. ولم تكن الجماهير التي جمد وعيها ووضعت خارج السياقات أن تتهيأ لمثل هذه الثورة الذهنية. لاحظنا كيف يستأنف الفولكلور حياته بكل سهولة وكيف يشتد الطلب على الكلام الفارغ والشقشقات الموروثة وعرفنا الأسباب القريبة والبعيدة. كان الحراك الأمازيغي خلال هذه الفترة يحنط مظاهر التعبير الموروث ويجعل منها أدوات التماسك في وجه ما يراه طمسا وتغييبا غير أنه لا يلام كثيرا لأنه هو نفسه ورث الروح التقليدانية من أشكال الوعي الأخرى. شكل التعاطف مع الأطروحة الإحيائية للتراث الأمازيغي سببا في أوساط النخبة بمن فيهم نخبة الطلاب لتجميد النقد العلمي للتراث خاصة منه النقد الجذري. اكتفى الملاحظون بمراقبة تغيرات سطحية حدثت خلال القرن العشرين بين أغاني الروايس وأشعار النظامين والروايس وبنيت دفاعات منيعة ضد سلاح النقد التاريخي باعتبار التراث وسيلة للدفاع السياسي عن الأمازيغية وحفظ الذات من الضياع. اكتفي في باب التجديد بإدخال الات وايقاعات وألبسة وفضاءات وموضوعات. حدثت في هذا السياق طفرة أرشاش التي كنا ننصت إليها ونحاول أن نبحث عن ظلال مدرستها في المجموعات القريبة منها. نعزف ألحانها أحيانا محاولين محاكاة النغمة الخاصة على الة البانجو لاكتشاف سر لمسة الحسين وخاش، ونحفظ كلام شاعرهاعلي شوهاد لنستخرج أعماق ما في كلامه ويستخرج هو أعمق ما في أنفسنا من أحاسيس بشخوصنا وزماننا. ونساير أحايين أخرى بطبول النفس خزانة الايقاعات التي أبرزها جمال الأغاني ونستريح من إيقاع المدينة الذي يتحرك أسرع مما ننتظر ونقدر. كانت عمومتي وأخوالي وأبناؤهم يدمنون سماع غناء أرشاش ويعرفونني بخباياه: أسرار تلك القصيدة ولحن هذه القطعة وإيقاع تلك المعزوفة. ينبهونني إلى الكورال العذب والحكمة المصدقة، ويشرحون ما استعصى من الألفاظ. خلاصة الأمر أنهم يستبهمون مثلي سبب ورود هذه المصادفة الغريبة التي اجتمع فيها ما تفرق في غيرها: الشعر الأصيل الحكيم واللحن الواضح المطرب والايقاع الحي والأصوات الشجية. أما والدي فقد كان من عشاق بوب مارلي والجاز وكان يعتب على أغنية جمايكا ووصف غناء مارلي بالخسر. كانت فئة من الذين جايلهم أبي يعبرون بمعانقة هذه الحركات الموسيقية والبهلوانية ويظهرون العصيان لأوضاعهم بما أن حاجاتهم النفسية التربوية وأوضاعهم المالية كانت في غاية الصعوبة أما أمي فتسمع كالقرويات للراوايس بينما يسمع شباب قريتي أغاني المجموعات. كانت هذه الموسيقى بعض وسائل التماسك. موضة اللباس وقصات الشعر وحكمة المجاذيب والتصوف الكاذب المشوب بلسعات النقد السياسي الفج والام المعذبين في قبضة السلطة كانت بعض طرق التعبير الملتوي. لا أعرف كيف كانت أجيال المغاربة تفهم العلاقة بين التراث والحداثة والعولمة وكيف كانت تفهم حركة التاريخ من خلال الإنتاج المادي والإبداع الجمالي.
يوجد في قصائد أرشاش ما ارتفع معه مستوى الوعي وعزف على وتر كان مفقودا. “أرݣان ” و” سيدي حماد” وغيرها كثير تشعر بين الفينة والأخرى بالحاجة إلى تعبيرية من هذا النوع. سبق لناس الغيوان ان عزفوا على هذا الوتر مستعملين الكلام المغربي الجزل فتأثر بهم المغاربة. اعتبرت الحكمة الاجتماعية والأخلاقية والدينية عصب الإنتاج الشعري والغنائي في هذه الأجواء، ولدت تازنزارت هي الأخرى في مثل تلك الأجواء وفي مناخ أقل كفاءة. تفوقت تارشاشت في مضمار الوعي تفوقا بارزا لا تستطيعه تازنزارت، بل إنها لا تقارن أصلا بتارشاشت المتعملقة. إنك لا تحصي في تارشاشت من ملامح العبقرية والنبوغ والإجادة إلا بقدر ما تحصي في تازنزارت من ضعف وأخطاء، ومع ذلك شكل البحث عن الامتلاء والبحث عن الذات والخصوصية سببا دافعا إلى التعلق بالأصوات والآهات والصرخات والألحان والأشعار المتداعية وتحميلها ما لا تحتمل وتصنيفها في خانة الفن لا الجمال.
لابد من مقدمات من هذا النوع حتى أقول ما أفكر فيه حيال ظلال تارشاشت. هناك حيث جلس الكثيرون يتأملون ويتجرعون اللذة المؤلمة ويسعدون بالطرب والخطاب الجديد الواعد.
كان الشاب حسن وارݣي أحد هؤلاء الذين يمكن أن ترى بوضوح تأثرهم بأرشاش. عندما تتأثر بأرشاش فلابد حتما أن تهتم بالكلمة وبالنغم وبالإيقاع، وهذا ما فعله الشاب حسن مع رفقة من أصدقائه. كنت أعرفهم كما قلت على الشبكة وعرفت أنهم من الذين استنسخوا سر المدرسة الأم وما في محيطها الجنوبي الشرقي من عبقريات أصيلة، وأنهم سيصلون يوما ما إلى إظهار ما خفي أو ربما لم يخف على كثيرين في خطاب أرشاش. كنت في هذه السنوات أسمع كلاما من نوع أن أرشاش قد تحولت وأن إبداعها بلغ ذروته، وستطويه عوائد الزمن في الطي والنسيان، وأن المجموعة تفككت وأن صراعات من نوع التي نعيشها كل يوم بسبب المال والعمل والمنافسات غير الحميدة لن نتترك شيئا جميلا حتى تفسده، وقد انتهى أصلا زمن التأمل وانقهر البصر بوميض العملة، وأسرعت عقارب الساعة خلف المدن وعرفت كل أنا أناها. كانت نبرة الحزن تغلب من يقول أن الذكريات الجميلة قد انتهت وأن البادية قد انفتحت بسرعة غريبة وتحولت وأنه لا سبيل إلى محاصرة ظاهرة التآكل والتحول. لم أصدق أنا يوما أن باب الاجتهاد والابداع قد أغلق وأن شيئا سيئا يحصل وأن قضايانا قد انحلت وأن الغاية من التأمل قد بلغت، وفوق ذلك كله لا يزال علي شوهاد في نظري قادرا على مفاجأتنا.
مشيت في ليلة صيفية بحي تالبورجت عكس حركة السيارات والمارة ولا أعرف سبب سلك تلك الطريق التي سلكتها فعندما تكون طالبا بأكادير لا تهتم كثيرا بالطرق التي تسلكها لأنك قبل ذلك لا تعرف الوجهة، حتى وقفت أمامي سيارة خفيفة وفتحت زجاج نوافذها لتقع عيني عليهم. أعضاء مجموعة لبوشارت أو بعضهم. إنه والله حسن وبعض أصدقائه. لا أذكر أن عمر كان معهم.
_ السلام عليكم. هل تعرف الطريق إلى ساحة الأمل؟
_ نعم. اذهبوا مباشرة إلى ملتقى الطرق وانعطفوا يمينا. سيقودكم الشارع إلى محيط ساحة الأمل.
وأنا متردد ومندهش.. تنطلق السيارة فتصدر مني هذه العبارة ” تبارك الله على لبوشارت”. تتوقف السيارة من جديد وينادي علي ركابها.
_ هل تعرفنا؟
_ نعم
_ نحن ذاهبون إلى سهرة عبد الهادي إݣوت. ألا تذهب معنا؟
ذهبت معهم على متن السيارة. لم يكن الشبان يعرفون أنني ذهبت معهم ليس إلا لمشاهدتهم لا لمشاهدة إݣوت، وهو الذي لم يعن لي طول حياتي في عالم الفن غير عازف بارع ككل العازفين البارعين وصوتا قويا ككل الأصوات القوية ولا شيء غير ذلك ما يقال عنه. عبد الهادي ليس شخصية فنية وليست عنده أفكار فلم أعنى به.
كان وقوفنا أمام المنصة أشبه بدرس طويل لي والشاب حسن ينتظر تلك القطعة أو غيرها من إكوت فيظهر لي براعتها ويرددها معه وأنا أفهم في ذلك الوقت أن من يهوى العزف لابد أن يهتم بالأتار وأنواع الالات وجودتها وموضع المقامات وكل أسرار الصنعة. لابد أن يدرب أذنه ويعرف كل دقيقة في العالم الذي يقبل عليه: عالم المغنين. إنه إذن في سفره هذا يصقل موهبته ويزكي مهاراته كما رأيته يفعل على سفوح بلدته. أما أنا فأهتم بفنون الكلمة من شعر وقصة ورواية. أريد اللغة الواعية وأريد من تلك اللغة أن تعكس فنيا حركة الوعي وأريد من
ذلك الوعي أن يقبض على حركة التاريخ ويبني علاقة حسية معه. نحن أمة منكسرة جريحة ومتأخرة ولابد أن نربط سعادتنا بتحسين أوضاعنا ومناقشة ظروف وجودنا في العصر الحديث. ثم انتهى لقاؤنا على أرض الواقع ولم تنته متابعتي لهم. أسمع الأغاني والإصدارات. أتابع أداء القطع التراثية وقرض الأشعار ومجالسة الأجانب. يوجد في تاريخ أرشاش شيء من ذلك كله. إحياء القطع التراثية وقرض الأشعار والبحث عن العالم الخارجي في أعمال علي شوهاد وتطلعاته.
ما دفعني إلى الكتابة عن هذه القصيدة ” تيقبورين” التي تغنت بها مجموعة لبوشارت أنها تحمل وعيا خفيا يؤثر فيها حيال ذاكرة اللسان والأرض والإنسان وأن فيها سطرين أخيرين يتحدثان عن دورة الزمن ومرحلته المظلمة. يوجد في القصيدة أكثر من سبب لطرق موضوع الافاق الممكنة لمشكلة التعبير الفني الأمازيغي وعلاقته بأشكال الوعي خاصة الوعي القومي الأمازيغي.

ليطالع القارئ نص القصيدة مع قراءة عروضية لها وليعد إليها لدى دراسة الشكل تحت العناوين الصغيرة، ثم ليتابع بعض ما ألقيناه عليها من أنظار وما أثرناه من مشكلات باقتضاب شديد.
ݣيغ أقبور أر نݣمي أر نفرن أوال |
ݣي/غاق/بو/را/رن/كم/يا/رن/فر/نا/وال |
أر نزاض أر نكرز نسروت أر نسيفيف |
أ/رن/زا/ضا/رن/كر/زنس/رو/تا/رن/سر/وات |
نمون ئ تويزي تيݣوروين نمون أسنت |
ن/مو/نيت/وي/زي/تي/كور/وي/نن/كو/نا/سنت |
نمون أ نبنو تادارت نمون ئ واوال |
ن/ مو/نان/بن/نو/تا/دار/تن/مو/ني/وا/وال |
سوغ ئݣران ئمندي ؤسيخ ت س لخنشات |
سو/غيݣ/را/ني/من/ديو/سي/خت/سل/خن/شات |
أر نتاݣم أر نزوزورسنحفرخ أكال |
أ/رن/تاك/ما/رن/زو/زور/سن/نح/فر/خا/كال |
تيرام ئبريين د ؤودي ؤلا كم أ تامنت |
تي/را/ميب/ري/ين/دو/ديو/لا/كم/ما/تا/منت |
باداز ؤلا سكسو د ؤفراس ئكافا ياغ |
با/دا/زوو/لا/سك/سو/دوف/را/سي/كا/فا/ياغ |
سنوخ أغروم ف ترݣين سوقغخ س ئكروان |
س/نو/خاغ/رو/مف/تر/كين/سو/قخ/سي/كر/وان |
أز نساغ أر نزنزا لفرح ئلا لامان |
أ/ رن/سا/غا/رن/زن/زال/فر/حي/لا/لا/مان |
نݣ أمان غ ؤيديد نسو أتاي ن تاكات |
ن/ݣا/مان/غو/يد/دي/دنس/وا/تا/ين/تا/كات |
نغي لوز د لكركاع نسكر تيفالاتين |
ن/غي/لوز/دل/كر/كا/عنس/كر/تي/فا/لا/تين |
أداكو ن رقاب ئصحان أس نترقاس |
أ/دو/كو/نر/رق/قا/بيص/حا/نا/سن/تر/قاس |
أملحاق د ؤجلابي تيملسيت لملف |
أ/مل/حاف/دو/جل/لا/بيي/تي/مل/سي/تل/ملف |
ئسوياس د ئموريݣ ئحلان أغا تيليخ |
ئ/سو/ياس/دي/مو/ري/كيص/حا/نا/غا/تي/ليخ |
نكشم أسرير تنضامت أر نتافا أوال |
ن/كش/ماس/ري/رت/تن/ضام/تا/رن/تا/فا/وال |
ؤر أر نتغاوال أد نطف لمال ن قارون |
ؤ/را/رنت/غا/وا/لا/دنط/فل/ما/لن/قا/رون |
وا قنعاغ س أينا دارخ ئلان ئكاف أخ |
وا/قن/عاغ/سا/ين/نا/دار/غي/لا/ني/كا/فاخ |
ؤلخ تاسݣلت لميزان ن ئفيلي سنخ أس |
ؤ/لخ/تاس/كل/تل/مي/زان/ني/في/لي/سن/خاس |
سنخ ئ لوح د تزاݣورت ؤلا ياساتور |
ݣيغ أقبور نكا درست ؤرمخ أماوال |
ݣي/غاق/بو/رن/كا/درس/تو/رم/خا/ما/وال |
نورم تاولا نغلي د ئسيوان ؤلا أسيف |
نو/رم/تاو/لا/نغ/لي/دي/سي/وا/نو/لا/سيف |
ئغ ؤر نوفي شمع أمكوك أس نسيفيو |
ئ/غور/نو/في/شم/عام/كو/كا/سن/سي/فيو |
ݣين ئتران غييض أسفيو ؤلا أيور |
كي/نيت/را/نغ/يي/ضاس/في/وو/لا/يا/يور |
ئمندي ئمون د لغلت ئران ليقين |
ئ/من/ديي/مو/نن/دل/غل/تي/را/نل/يا/قين |
أد أغ ئتصاحان نبيكس ئميمن ووسان |
أ/دا/غيت/صا/حا/نن/بيك/سي/مي/من/وو/سان |
أزرݣ ن زمان ئسودا فكان أغ ئ تيلاس |
أ/زر/ݣنز/ما/ني/سو/داف/كا/نا/غي/تي/لاس |
تاوالا أ تݣيت أ تودرت تينخ نورم تنت |
تا/وا/لات/ݣي/تا/تو/درت/تي/نخ/نو/رم/تنت |
الشعر والموسيقى:
سأشرح هنا مشكلة دقيقة لا تطرق كثيرا تميز الشعر عن الموسيقى بما أن نقد الفنون عندنا ضعيف للغاية. إن كل صور الجمال واللذة تدر على الدماغ إفرازات كيميائية ونواقل عصبية يسمع الناس على الأقل منها بالدوبامين، وهي التي تشعره بالنشوة والفرح والرضا وتشكل لديه ذاكرة المتعة ومن خلالها يتشكل نظام الإدمان العصبي الذي يعمل سلبا وإيجابا في حياة الإنسان، وقد يلاحظ الناس علاقة بعض الأوساط الموسيقية بالمخدرات والسكريات والجنس لأن هذه محفزات للإفرازات المنشطة المشعرة بالمتعة. يسجل الدماغ البيانات التي يتلقاها من الخارج عبر السلوكات والحواس أو الدورة الدموية. يجمع المعطيات من البيئة كما يجمع الذكاء الرقمي المعلومات من الشبكة العنكبوتية عبر أنظمة الربط والتشفير ويتعامل بها كاللغة والأحكام الجمالية ونكهات الطبخ والروائح والأحكام القيمية ويشكل بها ذاكرة بنيوية منذ الطفولة تتفاعل وتستدمج كل جديد بشكل جدلي. لهذا يحب كل شعب موسيقاه ورقصه ومطبخه وألبسته. يحكم عليها إيجابيا ويمج غيرها إذا لم ينفتح على غيرها بالشكل والدرجة الكافيين لتدخل ضمن عناصر التكوين المؤثرة على البنية. هذا ما يحصل في أصوات اللغة عندما يكتشف شعب ما أصوات لغة أخرى فينطقها مشوهة وهي في سمعه سليمة حتى يعيدها الاف المرات وتدخل البنية كوافد جديد. يربط الدماغ بين المعطيات المخزنة ليبدي ردة فعل أمام كل حدث جديد أو مذاق أو موسيقى ويحكم عليها بالبنى بشكل لا يفهمه الإنسان.
إن الإنسان لا يفهم كيف تؤثر فيه الموسيقى الصامتة المجردة فيعزو تأثيرها إلى الغموض أو اختيارات النفس أو الذوق أو سحرية النغم أو النزوع الروحاني للإنسان وغير ذلك مما لا صفة عقلانية واضحة له.
تكمن صعوبة فهم الموسيقى ( لا أقصد علوم النوتة بل النغم) في تجريديتها العالية جدا ففي الموسيقى لا يوجد معنى. النغم يثير في الانسان مشاعر مختلفة وعشوائية دون فهم سبب لذلك وقد تكون تلك المشاعر خطيرة عليه إذا لم يعها ويتحكم فيها بناء على حاجاته وأوضاعه وهمومه. أما فنون الكلمة ومنها الشعر فتؤثر بالوزن الخفي والايقاع والصورة والمعنى. كل كلمة لها دلالة وكل جملة لها إفادة وبالتالي فالمعنى يقيد الشعور ليجعله في نطاقه. الشعر يؤثر ويجعلك تفكر في ما يعطيك من معان بينما تؤثر الموسيقى فقط وتجعلك تفكر في ما تهتم له ليتشكل إدمان عشوائي.
عندما يجتمع الشعر والموسيقى في الغناء فتلك مناسبة لنفهم ما يحصل، وهناك طبعا على الأقل نوع من الغناء يسمونه غناء ملتزما ويقصدون به وجود معنى كبير أثناء الغناء. تحدث الموسيقى في الدماغ الاستجابة اللازمة ويتدخل الشعر لتوجيه الشعور عن طريق المعنى. معاني الشعر قد تكون بسيطة وهذه تفهم بسرعة وعامة الشعر الأمازيغي من هذا النوع. لا زال الحب والفقد والموت والفراق والصراع والغدر ومشكلات التربية والعقد النفسية وأخلاق الجموع موضوع كل ساعة. هذه المشاعر يسهل إفرازها ويسميها البسطاء بالواقع والحقيقة ظانين أنها الواقع والحقيقة حقا، أما الأمازيغية والوعي بشروط نهضة الإنسان الأمازيغي ومشاعر التخلف عن العالم وحجم مهام الإصلاح اللازمة وحظوظ النجاح فيها وحجم التخلف فهذه لا تفهم ولا تفرز بسهولة. قد تجول أطيافها بالذهن ويعجز النغم عن ربط علاقة واضحة معها وتمثيلها وتعجز الحكمة الشعرية والفلسفية والأخلاقية والاجتماعية فضلا عن الوعي الأيديولوجي المباشر كما تفعل فاطمة تابعمرانت وقبلها محمد الدمسيري ويفعل الشباب الذين ذهبوا إلى الانزياح في القصيدة النثرية. الوعي موجود والتعبير مفقود. قلت مرارا أن هؤلاء يمثلوننا لكنهم لا يعبرون عنا كبعض نواب البرلمان.
التعبير هو عبور المشاعر القومية والتاريخية الكثيفة الملتبسة والمعقدة من الذهن إلى القوم وتبادلها على طريق البحث في الذات عبر مادة تمثيلية غير مباشرة. مادة التمثيل هي الصباغة للتشكيليي والسردية للقصاص والصورة والوزن للشاعر وشكل استعمال تلك المادة هو الفن، أما الناقد فيراقب طريقة تحويله المادة إلى فعل فني ممثل لمازق الأمة ليقيس مستوى فنيته إن وجد. يكشف عن علاقات المنتج الفني الداخلية لفهمها وربطها بما في خارج النص وصولا إلى تحديد قيمتها التاريخية وأهليتها لمخاطبة الأمة القومية. إن قومنا استخفوا بالنقد أيما استخفاف فجعلوه مثل مهام المعلمين وهم يصححون إنجازات المتعلمين لذا رفضت دوما أستاذيته وأسقط من كرسي العالِمية. أين نحن في الشعر من دراسة تعبيرية القصائد؟ أين نحن من طول القصيدة بدل عرضها؟ أين نحن من علاقات الفن بأشكال الوعي؟ أين نحن من ربط الشعر بالتاريخ؟ أين نحن والدولة من تمييز الجمال عن الفن؟ أين نحن من تكوين ذهنية جديدة للقادرين على التعامل بمواد الفنون كالأصباغ والأوزان والسرد وغيرها؟ أين نحن من الوعي الفني؟
بما أن هذه المهمات صعبة والشعر والموسيقى وسائر الفنون الأخرى صارت عرضة للباحثين عن مواد التنشيط والإلهاء والتعبير الذاتي النرجسي ومعالجة الآفات الاجتماعية وتصريف الخطاب فضلا عن إيجاد المهن والتموضع في المجتمع المعاصر فقد ربط الوعي الأمازيغي تمثيلية الفنون له باستعمال اللغة والانتماء إلى التراث وحفظ الذات، ولم يطمح إلى نقد التعبيرية بشكل عميق واعد. هكذا أصبح يرى شباب في الولايات المتحدة الأمريكية أن بكائيات مبارك أيسار وربابة سيدي شنا تمثل الفن التعبيري الأمازيغي ويرى اخرون أن ” امي حنا ” تمثل الفن الأمازيغي وغناء عبوش وبوجمعة وكل هذا في حقيقته من الفولكلور الميت والمتخشب والمميت ولا يصلح الا للدراسة.
الكلام:
ݣيغ أقبور أر نݣمي أر نفرن أوال
ݣي/غاق/بو/را/رن/كم/يا/رن/فر/نا/وال
تستهل القصيدة نصها بفعل الكينونة “ ݣ” ” ݣيغ” ولم يتصل إلا بضمير المتكلم الفرد. هو إذن تعريف بالأنا. يعرف المتكلم نفسه بالتاريخ والزمن الضارب في القدم” أقبور”. تغري كلمة ” أقبور” المتحدث اليومي بدل ”أزايكو” لإحالتها السامع على القبر. كل من يوسد في القبر يطول به الأمد هناك فيصير القبر ودفينه علامة على الدهر. ليس شاعر القصيدة ميتا ولا معمرا بل هو ذلك الإنسان الأمازيغي الذي يرى في حياته دفينا في الزمان لا في التراب، وربما كانت كثير من حقائقه في التراب حقا وفي أدغال الماضي. بلى هو حي ناطق وفي كلامه يوجد ركن هويته. استعمل للنطق والكلام فعل ” ݣمي” مع ضمير المتكلم الجمع هذه المرة، ودون ملاحظة أي شيء على ذلك لنتأمل فعل النطق والكلام الذي يتمازج مع فعل القراءة والتهجي ومنه ” أ ݣماي” أي التصويت بحرف من حروف الهجاء. اللغة مظهر قوي من مظاهر الهوية. وهل هناك حاجة ما إلى إثبات الكلام والتلفظ في سياق التعريف بالذات أم أنها الحاجة إلى إثبات القراءة والكتابة والدرابة عليهما. في تاريخنا الطويل وصلت إلينا اللغة بكل أمية وسلاسة، هذا واللغة ظاهرة جماعية تنتشر في نطاق واسع فهل شكل التعليم باللغة العربية والفرنسية في المدرسة الوطنية وعيا بمشكلة الكتابة في التاريخ الأمازيغي أم تأطيرا إيديولوجيا للمعارضة الوطنية( المعارضة كنقد لبرنامج التحديث واستكمال لنقائصه)؟
يستكمل السطر بالحديث عن ” أفران” الذي يؤدي معنى النقد والتمحيص. يومئ الشاعر هنا إلى معرفة أسرار اللغة وتعبيرها الجزل. يتميز سكان البوادي عن غيرهم في حفظ اللسان من كثرة الدخيل.
دراسة الشكل:
نعثر في هذا السطر الأول على وزن الأحوزي الكبير وهو أشهر وزن شعري في بيئتنا، ويسمى كبيرا تمييزا له عن شقيقه الأصغر وليس أبدا بأكبر الأوزان الأمازيغية كما قد يخيل فهو اثنا عشري إلا أن ينقص مقطعه الأول. تلك الظاهرة هي التي سماها الأستاذ داود السوسي في كتابه ” أسقول” ب ” أسمود أمزوارو” أي إسقاط مقطع ” لا” في بداية السطر. لكن الوزن في قيمته كبير فلو ذهب كل وزن بما ألف نظم فيه من القصائد لذهب الأحوزي الكبير بسهم وافر.
الأرض والحياة الفلاحية:
أر نزاض أر نكرز نسروت أر نسيفيف
أ/رن/زا/ضا/رن/كر/زنس/رو/تا/رن/سر/وات
نمون ئ تويزي تيݣوروين نمون أسنت
ن/مو/نيت/وي/زي/تي/كور/وي/نن/كو/نا/سنت
نمون أ نبنو تادارت نمون ئ واوال
ن/ مو/نان/بن/نو/تا/دار/تن/مو/ني/وا/وال
سوغ ئݣران ئمندي ؤسيخ ت س لخنشات
سو/غيݣ/را/ني/من/ديو/سي/خت/سل/خن/شات
أر نتاݣم أر نزوزورسنحفرخ أكال
أ/رن/تاك/ما/رن/زو/زور/سن/نح/فر/خا/كال
تركنا السطر الأول وهو يثبت ما لإنسان البادية من قدرة على حفظ اللسان وبالتالي حفظ بيضة الهوية به. البادية هي تنظيم ناتج عن نمط الإنتاج الزراعي المعاشي القائم على فلح الأرض وجمع الغلال وتربية الماشية، ويتضمن ذلك أعمال الحرث والبذر والحصاد والدرس والسقي والطحن وغيرها. يقودنا السطر الثاني إلى التفكير في مظهر من مظاهر الهوية كما يراها الوعي الأمازيغي وهي التجذر في الأرض” أكال”. الفضاء الجغرافي ليس مجرد رقعة بل منشط من مناشط هذا الإنسان. الأرض تغذي جيشها والجند بعد ذلك يعرفون مهامهم في حراستها. تترك الحياة الزراعية إرثا في الأدوات والسلوكات وتترك ذاكرة. يحتفل اليوم بهذا التراث المادي في المتاحف الوطنية ويعتبر أمازيغيا دون أن يربط بالاقتصاد الزراعي. إن الدارسين يقفون على الحياة المادية للشعوب، ويعتبرونها أهم ما يوجد في المجتمعات ويشرح بوضوح إنتاجها الأدبي الفوقي من لغة وقانون وفكر وفلسفة وعلوم وتنظيم اجتماعي وعسكري وسياسي. سيكون إذن من اللازم التمييز بين طريقة الإنتاج التي كانت سائدة في القرون الوسطى وما قبلها وتبين أثرها على المجتمع الأمازيغي وبين ما الت إليه البادية المغربية بعد الاستعمار ونشأة المدينة المغربية إذ كلاهما معني بشؤون الأمازيغية.
نلاحظ فعل الاجتماع ” نمون” على أعمال الفلاحة والتي يطلق عليها ” تيويزي” والفعل لا يذكر فقط بالروح الجماعية للبادية بل الإحساس بدفء التطبيقات الاشتراكية الماضية. وجد هذا الجدل الذي خلقته الحركة اليسارية بالمغرب بسبب النقد الموروث عن الغرب للبرجوازية الكبرى. رفض الوعي الأمازيغي لأسباب بسيطة النقدي اليساري للأوضاع، وساهم ذلك في إهمال الأسس المادية للحياة الماضية. ربط النقد التاريخي القريب جدا من الماركسية العلمية فسقط كل شيء. ظهرت أصوات جديدة في أوساط الوعي الأمازيغي تؤكد الحاجة الماسة إلى ماركس رجل التاريخ والثقافة ورجل العلم الصلب. اقتنعت هي بذلك بعد سنوات من التمدن ومراقبة الحركة العمالية ونمو البرجوازية الصغيرة وتناسل مشكلات البادية وعجز برامج الدولة أمامها وارتفاع الوعي والتعليم .
إن النزعة الجماعية العميقة التي يضمرها الفعل السابق منافية للفردانية التي تميز المجتمع الحديث وكررت في اخر السطر ” نمون ئ واوال” بمعنى اجتماع الكلمة. الكلمة الواحدة صفة غالبة على المناخ القروي حيث لا تتصور التعددية لأن المجتمع غير طبقي على خلفيات إنتاجية صناعية. سيظهر مع الفلاحة عمل ينتمي إلى مجال العمارة استدعاه فعله الاجتماع ” نمون” لكن علاقة خفية تستدعي ذلك أيضا. الاجتماع على أعمال التشييد والبناء أقحم مع أعمال الزراعة لسبب واضح هو أن عمال الزراعة هم نفس عمال البناء. يوسع الفلاح مخازن غلاله ومحاصيله فيستعمل تربة أرضه وصخرها وجذوع شجرها وقصبه وماء ساقيته وتبن بيدره وأدوات فلاحته فلماذا يتخلى عن عمال حقله؟ إنهم نفس أعوانه الذين لا تتشكل منهم فئة في مستوى الطبقة. هذا في حدود البادية ولم تعد الأوضاع كذلك. هذه مجرد ذكرى.
أعمال زراعية تفسر جمود البادية وقد تجمد الأمازيغية أيضا ووعيها إذا لم ينتبه إلى هذه العواطف وهذا الربط الذهني بين حياة الإنسان المادية وبين الأمازيغية والتوسط لذلك بنقد الحداثة والرأسمالية والنمط المستقل في الإنتاج والمزاعم الايكولوجية والبرامج الصحية والتعلق بالطبيعة وغير ذلك من المخارج الخطرة.
المطعم والمشرب:
تيرام ئبريين د ؤودي ؤلا كم أ تامنت
تي/را/ميب/ري/ين/دو/ديو/لا/كم/ما/تا/منت
باداز ؤلا سكسو د ؤفراس ئكافا ياغ
با/دا/زوو/لا/سك/سو/دوف/را/سي/كا/فا/ياغ
سنوخ أغروم ف ترݣين سوقغخ س ئكروان
س/نو/خاغ/رو/مف/تر/كين/سو/قخ/سي/كر/وان
أز نساغ أر نزنزا لفرح ئلا لامان
أ/ رن/سا/غا/رن/زن/زال/فر/حي/لا/لا/مان
نݣ أمان غ ؤيديد نسو أتاي ن تاكات
ن/ݣا/مان/غو/يد/دي/دنس/وا/تا/ين/تا/كات
نغي لوز د لكركاع نسكر تيفالاتين
ن/غي/لوز/دل/كر/كا/عنس/كر/تي/فا/لا/تين
تنعكس الحياة السابقة في البادية على المطعومات والمشروبات فلا تكون إلا من محصول الأرض وغلال البساتين وزيوتها ومستخلصات الألبان وخلايا النحل. تغادر الحياة الزراعية وبقاياها الأرض لتستقر في الذوق وتكتسب طابع التجريد. تدخل ضمن عادات غذائية تصبح أجواء إعدادها ومناسبات تقديمها ودفء تناولها مع القرابات والجيران ذاكرة قوم يتذاكرون بها. هم الان يعيشون في كل مكان ولا يصبرون على ذلك الطعام إلا قليلا. يفطرون على العصائر والمخبوزات وسلطات الفواكه ومشتقات الحليب ويتغذون بلحوم البر والبحر، أبيضها وأحمرها ويصنعون أشهى ما في الخضر والقطاني من أطباق، لكنهم يتذكرون تلك الأطباق التي يخالون أنه لم يكن للأغيار دخل في وجودها.
“بادراز و سكسو د ؤفراس” التي ترد في القصيدة وهي طبخات من شعير أو قمح تشكل مظهر خصوصية أو هوية في أوساط الذين يعرضونها في المناسبات على أنها رمز لا وجبة ويلطفون صورتها بالحلوى الصناعية والخبز المقلي والفشار وسائر النعم كما في رأس السنة. إن هؤلاء يبحثون عن وسائل التعبير عن الوجود المستقل أي الهوية الخاصة ثم ينسحبون بسرعة إلى بذلاتهم ومطاعمهم في حياة المدن العصرية، أما الذين تشكل تلك الأطعمة وجباتهم اليومية أو بعضها فهم ممن لا تزال الحياة الزراعية وما بقي منها طريقة عيشهم أو بعضها.
هكذا يكون الشاي وقربة الماء وأثافي النار مظاهر حياة يحن إليها من يحن إلى دلالاتها البعيدة: جود الأرض وخصوبتها وإنجازات الإنسان عليها وعطفها عليه. يرى غيرهم ذلك بساطة طافحة أو شحا أو شظفا في العيش. هؤلاء لا يجربون شعور البحث والتماسك، ولعلهم لا يفهمون شعور من قال من الشعراء أنه يحن إلى خبز أمه وقهوتها فيظنون أن الخبز والقهوة في كل مكان.
سمن ذلك السطر الشعري وعسله هو مزيج من لذة وسعادة يتذكر بهما الطفل الكبير أيامه بين أودائه وطقس عائلته وباديته وأولى المذاقات الحلوة قبل أن تجرعه الدنيا مرارة الصغار والغربة والضياع. لهذا يتذكر بعدها الشاعرعملة السعادة الرائجة في أسواق الطفولة والبادية
أر نساغ أر نزنزا لفرح ئلا لامان
بتلك العملة يبيع ويشتري، يعطيها ويأخذها جزافا، عملة الفرح. بها يحصل الأمن والطمأنينة والسكينة التي يمسحها شقاء الوعي وعن تلك البساطة يقول الأديب السوداني الطيب صالح على لسان بطله مصطفى سعيد” يجوز أن تكون البساطة كل شيء”
الملبس:
أداكو ن رقاب ئصحان أس نترقاس
أ/دو/كو/نر/رق/قا/بيص/حا/نا/سن/تر/قاس
أملحاق د ؤجلابي تيملسيت لملف
أ/مل/حاف/دو/جل/لا/بيي/تي/مل/سي/تل/ملف
يتذكر الشاعر أيضا حذاء قدمه ” أدوكو ن رقاب” الذي تختزل ألوانه وزخارفه ونقوشه ما تختزله ألوان الأعلام عادة. عندما ينتعل المرء في بيئتنا نعل أجداده من هذا النوع المسمى فهو يستعد لسلك تلك المسارات بعزم وقوة ” أر نترقاس”. تلك قوة الشاب تنتظر الوجهة نحو ذلك الدرب الذي يوصله إلى ذاته. وقد كانت أقدامه من قبل استنسخت دروب أرضه وعرفت عاليها وسافلها وخبرتها بالتجوال. وصف النعل بالقوة ” ئصحان” لأن مثل هذا الدرب لا يسلكه إلا أمثال هؤلاء المشاة. ومرة أخرى يطفو حديث الهوية فالأمازيغ ينتعلون ما جد من أحذية بل ينتجونها ويروجونها لكن ” أدوكو ن رقاب” و ” شربيل ” مظهر خصوصية وتلك الخصوصية هي المقصد. لهم أيضا في باب اللباس غير لحاف النساء ” أملحاف” وجلباب الرجال ” أجلابيي” لكن البحث عن الخصوصية يحنط الذات في ما صار ينظر إليه على أنه لباس ” الهزيمة”. لباس الذهنية العتيقة التي قادت العلم إلى الجمود والدين إلى الطقوس والعسكر إلى الهزيمة. سيلاحظ القارئ أن الشاعر رفع من قيمة تلك الألبسة فجعل أتوابها من نوع ” لملف” وواضح أن ما يرفع من قيمته هو لباس الهوية.
الانسان الأمازيغي، ابن الحضارة
ئسوياس د ئموريݣ ئحلان أغا تيليخ
ئ/سو/ياس/دي/مو/ري/كيص/حا/نا/غا/تي/ليخ
نكشم أسرير تنضامت أر نتافا أوال
ن/كش/ماس/ري/رت/تن/ضام/تا/رن/تا/فا/وال
ؤر أر نتغاوال أد نطف لمال ن قارون
ؤ/را/رنت/غا/وا/لا/دنط/فل/ما/لن/قا/رون
وا قنعاغ س أينا دارخ ئلان ئكاف أخ
وا/قن/عاغ/سا/ين/نا/دار/غي/لا/ني/كا/فاخ
ؤلخ تاسݣلت لميزان ن ئفيلي سنخ أس
ؤ/لخ/تاس/كل/تل/مي/زان/ني/في/لي/سن/خاس
سنخ ئ لوح د تزاݣورت ؤلا ياساتور
ݣيغ أقبور نكا درست ؤرمخ أماوال
ݣي/غاق/بو/رن/كا/درس/تو/رم/خا/ما/وال
نورم تاولا نغلي د ئسيوان ؤلا أسيف
نو/رم/تاو/لا/نغ/لي/دي/سي/وا/نو/لا/سيف
ئغ ؤر نوفي شمع أمكوك أس نسيفيو
ئ/غور/نو/في/شم/عام/كو/كا/سن/سي/فيو
ݣين ئتران غييض أسفيو ؤلا أيور
كي/نيت/را/نغ/يي/ضاس/في/وو/لا/يا/يور
ئمندي ئمون د لغلت ئران ليقين
ئ/من/ديي/مو/نن/دل/غل/تي/را/نل/يا/قين
أد أغ ئتصاحان نبيكس ئميمن ووسان
أ/دا/غيت/صا/حا/نن/بيك/سي/مي/من/وو/سان
رأينا كيف أبرز نص القصيدة اللسان وهو حجر الأساس في بنيان الهوية والتراب ونشاط الإنسان عليه ليحين دور هذا الأخير.
لقد وجد بطريقة غاية في مجانبة الصواب ونتيجة للوعي الأيديولوجي هذا السؤال المشاكس:
هل الأمازيغ حقا أبناء حضارة؟
هل لهم تاريخ؟
هل لهم إنجازات؟
لو كانت ذكريات الشاعر في القصيدة مجرد حنين إلى البادية كما يحن إليها كثير من المنحدرين منها الهاربين من نظام المدن الصناعية الأوربية وضغوط المدن المغربية في أعياد الأضحى والفطر وعطل الصيف لما وجدناه في اخر القصيدة يثبت ما لإنسان القصيدة المتكلم من قدرات فنية ومهنية توجد في نسل كل الانسان العاقل الحديث الذي يستعمر كوكب الأرض.
إنسان القصيدة يقرض الشعر الجميل (ئموريݣ ئحلان) ولا شك أن شعره جميل فوق أنه شعر. هذا لمن يسأل: هل في الأمازيغية شعر كما في غيرها؟
بلسان القصيدة نعم وهو جميل مهم لأنه من إنتاج الإنسان المعني وبلسانه. هذا الذي وجد في المراقص الشعرية أولى الأبواق الرسمية التي أعلت صوته. هي رسمية لأنه بالنسبة للشعراء فاللغة الشعرية أعلى كعبا من نثر الشفاهة وربما كانت رتبتها مقارنة معها كاللغة الكتابية للغة الشفاهة.
الشعر إذن مظهر اخر لهوية يتكلم فيها الشاعر عن نفسه ولذا كانت لياقات الشاعرية بابا للإعلاء من شأن الإنسان وهويته إلى الحد الذي يقيم فيه الشاعر في مسارح الشعر باحثا عن الشعر في اللغة ” أر نتافا أوال” أو بالأحرى عن اللغة في الشعر.
البحث عن اللغة وآدابها هو مظهر للبحث عن الذات كما حصل في ألمانيا القرن التاسع عشر عندما أغرم مثقفوها وأدباءها باللغة الألمانية بحثا عن شروط تاريخية جديدة فكانت القومية الألمانية إيديولوجية أي فكرا غير مطابق للواقع لكنه يعكس بشكل غير مباشر حاجة واقعية مركبة إلى اللحاق ببريطانيا وفرنسا الحديثتين.
شاعرنا وشاعر المرقص يبحث عن ذاته واعتبار كينونته الموجودة في شعر لغته ولغة شعره، لذا فهو لا يغالي في مهوره ولا يطلب ما لا يعطاه. هو بنص القصيدة لا يطلب ثروة قارون ” لمال ن قارون” وليس الحل بعد ذلك إلا هذا التواضع المزيف والتنازل المفتعل. أن يقنع ويرضى بما لديه وماذا لديه غير شعوره بنفسه في هذا الشعر وهذه اللغة. ألا يسمع من ايديولوجيي الحواضر وفلكلور الدارجة مطالب إثبات الأهلية. أليس يسأل عن الأهلية والرشد والتاريخ والحضارة ولم يبق إلا إثبات الكرامة الادمية والوجود في التاريخ وهو للأسف ما صرنا نسمعه مع كشوف الجينوم. لقد بلغ الانحطاط الفكري بالأمة المغربية العظيمة هذا المبلغ الخطير. نسي الايديولوجيون المغاربة وايديولوجيو الدولة مهامهم وطرقوا أبواب الهمز واللمز.
إن بحث الشاعر عن الاعتبار والعثور عليه في المراقص بالشعر والنظم وتنازله عن المقابل الذي لا يعطاه أصلا هو تعبير عن البحث عن هوية غير معتبرة، وذلك يمس جوهر وجود الإنسان واعتبار كينونته وكرامته ولياقاته. تزكي الأحكام غير الأخلاقية والمعاملات المنحطة وضعف التنمية والاشراك والفوارق المجالية بين الشمال والجنوب والحاضرة والمدشر ذلك، لينتهي الأمر إلى غمز قناة الإنسان الأمازيغي وتشكيكه في نفسه ولا يجد هذا الأخير وسائل الدفاع إلا الدفاعات التراثية. يخصص جزءا من جهوده للبحث الانثربولوجي يثبت به لياقاته الإنسانية، فهو بنص القصيدة يتعامل بالموازين ويشيد المعمارات الهندسية كالجدران والأسقف والسواري كما فعل أسلافه في أسوار المدن وحماماتها ومساجدها وساحاتها ومخازنها وأبراج مراقبتها. إنسان قادر على النظم والبناء واستغلال الأرض والتحرك فيها. إنسان له لغته ولباسه ونعله وتحته خرائطه وطعامه وشرابه وفنه. إنسان ابن حضارة وتاريخ مستقل بنفسه. إنسان نبت حقا في منبت الأحرار ومشرق الأنوار. نعم مشرق الأنوار الذي ينظر فيه إلى افاق السماء يخاطب علياء النجوم والقمر فيرى فيها همته ويتذوق سعادته الوحيدة.
ݣين ئتران غييض أسفيو ؤلا أيور
ئغ ؤر نوفي شمع أمكوك أس نسيفيو
حتى لو عاش في عاصمة الأنوار باريس فليل بلدته أفضل من كشافاتها. في ليلة بلدته تنطفىء الشموع الذابلة فيستعيض عنها بغيرها ” أمكوك” ويتابع الحياة. تأملات الليل والهمة العالية تجعل المرء يمتلئ بمشاعر الأمل والفأل الحسن. هي التي تهديه في طريقه متلمسا سعادته الأبدية” ئميمن ووسان”. وفجأة يتبدل كل شيء ويذكر المتذكر أنه يتذكر ليس إلا وأن الطل ” أرشاش” لم يكن وابلا وأن الأرض لم تنل رواءها وأن الإنسان لا يزال في سقطته، وأن المشاعر مظلمة وأن البادية قد تغيرت ودار الزمان دورة عكس وأننا نتذكر لأن شيئا سيئا يحدث وأن البادية قد انفتحت وانجرت مع سيل الأحداث كما يجر كل البوادي وأن الكلام لا يكفي.
وفي نص اخر
ئشيض ئغ ݣنغ ئشيض ئغ أوكان ألغ
ئشيض ئغ تلاست أ دونيت فلانغ
أحينت أ ئمي رزاݣنت ئ لماسايل
أر لكمغ ݣار ئزماز غ ووسان ئنو
دورة الزمن وروح التاريخ:
أزرݣ ن زمان ئسودا فكان أغ ئ تيلاس
أ/زر/ݣنز/ما/ني/سو/داف/كا/نا/غي/تي/لاس
تاوالا أ تݣيت أ تودرت تينخ نورم تنت
تا/وا/لات/ݣي/تا/تو/درت/تي/نخ/نو/رم/تنت
شبه الزمن في اخر القصيدة بالطاحن الدوار وهو بعض أدوات الحياة الزراعية أيضا. هو جسم من صخرتين ثقيلتين مع مقبض يدوي خشبي يديره، وتنزل حركة الدوران بثقل صخرتها العلوية على الحبوب فتسحقها. الزمن هو الذي يدور هذه الدورة فيهشم ويسحق. الزمن معنى محايد يشبه الدهر لا أحد يكن له حبا فيرمى بكل العظائم. هو الذي قادنا من الليل الجميل المستنير إلى الظلام ” فكين أغ ئ تيلاس”. البادية عالم انتهى وبقي منه مظاهر لم تصل الدولة غير الحديثة اليها. عالم يهجره العمال والمثقفون والرياضيون والأطباء والفنانون. هو مجال جغرافي هش وخامل. يواجه فيه العمل وطاقاته العضلية والمتجددة وغير المتجددة مشاكل لا قبل لأحد بها، ويواجه فيه التعليم مشكلات غريبة. البادية مجال بلا تربية. التربية فيه هي التنشئة بالتقليد. أما الصحة والرياضة والعقل فيواجهون أمهات المشاكل ويواجه فيه الشباب ما يواجه الشيوخ ويندحر فيه الفن واللغة أيما اندحار بالشفاهة والفلكلور. تهان فيه المرأة والطفل والرجل والأسرة وتخرم فيه إنسانية البشر إلى الحدود التي لا يحسها البدو. يعرفها الانسان في ما بعد فيشعر بقسوة كل شيء إلا الأم. واقع البادية هو واقع مجالات كثيرة في المدينة أيضا لذا فالأمر يحتاج إلى تفسير. بما أننا الان ضائعون وأننا نقارن أنفسنا بالأجانب فتظهر الفروق الصارخة، وأن البلد يتغير بعيدا عن ما اعتبرناه هويتنا أي ” تمازيرت” بالطريقة التي فعلنا بها ذلك أي بالثقافة الانثربولوجية والفلكلورية فالأمر يحتاج إلى تفسير: ليكن التفسير هو الدور ” تاوالا” وليكن التاريخ هو الحياة والزمن ” تودرت” أي طبيعة الأشياء و أن لك يوما وعليك يوما. لقد مر علينا يوم سعادتنا ” تينخ نزري تنت” ونحن نتذكر تلك السعادة. هذا عزاؤنا في القصيدة والا ستظلم الدنيا في وجوهنا. قد يعود الدور الينا وينفخ فينا روح التاريخ من جديد كلما أعلينا من أنفسنا وماضينا وتراثنا ورغبنا في ذواتنا.
ئشيض ئغ تلاست أ دونيت فلانغ.
أما أن يوجد تفسير تاريخي اخر فذلك لم يعطه وعي الايديولوجيين المغاربة ولم ينتشر في الحياة الفكرية والسياسية ليصل إلى متعاطي الفنون.
لا يحس الناس بالعلاقة بين الوعي وأشكال التعبير وهذا خطر كبير.
إضاءة النص:
إضاءة النص هي تسليط الضوء الخارجي عليه. لقد كنا نتحرك داخله فقط مسترشدين بعلاقات أطرافه إلى أن استخرجنا بعض بناه، ووجدنا أن هناك وعيا تتساوي فيه ” تمازيغت” و”تمازيرت” و كان من الممكن البحث عن هذا الوعي الذي يريد أن يعبر عن حاجاته ونظرته الى الواقع ومهماته في قصائد أخرى، لكننا اخترنا هذا النص الذي لم يقل بشكل مباشر عن وعي تمازيغت ما قاله عبر الحنين الى تامازيرت. وجدنا أنه يقول ذلك بشكل مباشر في غيرها وأضأنا به ما قلناه من وراء الوراء. قال عن اللسان وعن وثائق الأرض وورثتها وحرف الزاي والفن النظمي ما سيقرأه القارئ في هذا النص الذي عنوانه ” الهوية” وليجب عن هذا السؤال؟
هل في عالمنا وفي عالم الابداع الجمالي والوعي شيئا متروكا للصدفة؟
نكي نكين أداݣ ؤ رئسن تاغارت
نسوا غ ؤݣوݣ نم أ تايري ن تمازيرت
تماݣيت ؤرا ݣيس نفل أ تمازيرت
أزا أ سرس أراغ أيدا ن تمازيرت
أزا أ سرس أراغ أرا ئ تمازيغت
ئنيغ أيوز نك ئ يان تنت ئسمغورن
أݣليف ؤفان أسغار لي ت ئجنجامن
نكين ؤفيخ أكدود ماد أغ ئسمغورن
أفكان ئران ئتران ئرا أ ت سمغورخ
نكين نݣا زوند ؤكان كا تاهيضورت
وانا ئرمين أ ݣيس ئتݣاوار ئسنفو
أزمز ئݣا ياغ نيت تاسمسرت س ئزيكر
نلول أروخ هان أراو غين أخ ئدا نو
نمل أس ؤلا تيݣوريو ما س تنظامن
أوال ئرا نيت باب نس أ ت سمغورن
ذ. اسماعيل أبلق